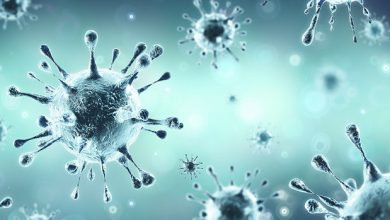الثقافي
طالب الرفاعي: المبدع أبقى

هو كاتب برائحة وطن. تذر نفسه منذ بواكير مشروعه الإبداعي أن يحمل عشق وطنه الكويت وهمومها، ليترجمها إلى أعمال فنية عالية، ذات نكهة كويتية أصيلة، بكل تفاصيل المكان وتحولات التاريخ وسيرورة الواقع. لقد رصد ذلك كله واستثمره وتفاعل معه بوعي ومعايشة فاحصة. فجاءت أعماله السردية في القصة والرواية خير شاهد على عبقرية هذا الكاتب العاشق الذي كتب (بوعجاج طال عمرك) و(أغمض روحي عليك) و(مرآة الغبش) و(حكايا رملية) و(سرقات صغيرة) و(ظل الشمس) و(رائحة البحر) و(الثوب) و(سمر كلمات) و(النجدي) و(رمادي داكن) و(مبادئ الكتابة الإبداعية) إلى جانب روايته الأحدث وهي قيد الطباعة بعنوان (حابي).
حوار: حسن المطروشي
إننا بكل تأكيد نتحدث عن الروائي والقاص الكويتي الكبير طالب الرفاعي. حاورته «التكوين» واقتربت من عالمه الروائي والقصصي، واستجلت فضاءاته الإبداعية الرحبة، وسألته عن الكثير عن رؤاه وأحلامه وذكرياته. في الحوار التالي يتحدث طالب الرفاعي …
في البدء نرحب بك في عُمان، وأهلا بك في مؤسسة بيت الغشام لنبحر معك في هذا الحوار.
أعبر عن بالغ سعادتي بوجودي في السلطنة، كما أنني سعيد بزيارتي لمؤسسة بيت الغشام، وبهذا الحوار الثري مع مجلة التكوين. وهذا التعاون بين المؤسسات الأهلية الثقافية يعد واحدا من أكثر أوجه السرور بالنسبة للمواطن العربي. المؤسسة الرسمية، وللأسف، ليست دائما قادرة على مد الجسور. وأجد أن هذا الوصل الإنساني الجميل قد بات يقدم شيئا من الأمل في لحمة عربية جديدة ومختلفة تساير العصر الذي نعيشة، وهو عصر المعلومات والاتصال.
بدأت تخصصك الدراسي في مجال الهندسة المدنية لتحدث بعد ذلك قفزة كبرى في التحول نحو الكتابة الإبداعية، حتى إنك أصبحت معروفا الآن كمبدع في مجال الرواية والقصة، أكثر من كونك مهندسا. كيف تصف هذا المسار على صعيد تجربتك الشخصية؟
أنا دخلت كلية الهندسة عام 1976م، في الكويت، ودرست الهندسة المدنية، وأنا أكتب منذ ذلك الوقت، ولم أتوقف عن الكتابة طوال مدة دراستي في الهندسة، إلى أن تخرجت في نهاية عام 1981م، وعملت في المجال الهندسي، وبالأخص العمل ميدانيا في الموقع لمدة خمسة عشر عاما، مع العامل والنجار والحداد ومساح الكميات وسائق «الكرين» والخلاطة وكل أطياف العمالة الموجودة في الموقع.
وقد بقيت خلال الخمس عشرة سنة محافظا على وجودي في الساحة الثقافية وبالذات في الفترة الأولى التي كرست فيها الكتابة في مجال القصة القصيرة، إلى أن جاء منعطفا آخر وهو دخولي في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وتركت العمل في مجال الهندسة، اعتبارا من 1996م.
لقد بقيت كاتبا، ولم أكتب طوال حياتي بقلم المهندس، فأنا أومن أن المبدع سواء كان شاعرا أم قاصا أم روائيا أم سينمائيا أم تشكيليا أم مسرحيا، هو أبقى بكثير من المهندس، مع احترامي وإجلالي لهذه المهنة الكريمة.
تعد استضافتك من قبل جامعة أيوا الولايات المتحدة في برنامج الكتابة الإبداعية تجربة ذات أثر عميق في مسيرتك الكتابية. هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟
إذا كان المنعطف الأول جاء بانتقالي من الهندسة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإن المنعطف الآخر جاء بانتقالي إلى جامعة أيوا الإمريكية حين تلقيت دعوة للمشاركة في برنامج الكتابة الإبداعية، وهو واحد من أقدم البرامج الكتابية في المجال الإبداعي بالولايات المتحدة، منذ ما يزيد على ربع قرن، إذ تجمع الجامعة سنويا أكثر من عشرين كاتبا من مختلف دول العالم ليتعاملوا مع طلبة الماجستير للحديث عن الكتابة كفعل، كيف يكتب الكاتب، ومن أين يستمد أفكاره وأشخاصه، وكيف يتمكن من التقاط هذه الوقائع الحياتية ويصيغها لتتحول كوقائع فنية. وهناك كان اللقاء الأهم مع الكتابة الإبداعية.
نحن في العالم العربي ننطلق من منطلق الموهبة والممارسة. وفي الولايات المتحدة، وتحديدا في جامعة أيوا بدأت أكتشف أن هناك دراسة قائمة بذاتها تسمى الكتابة الإبداعية. ويتعاملون مع الكتابة الإبداعية بوصفها علما له قوانين تمام مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء. صحيح أنه ليس هناك برنامج للكتابة الإبداعية يستطيع أن يصنع كاتبا، ولكنه يضع الكاتب أمام أساسيات الفن الذي يشتغل عليه.
بعد رجوعي إلى الكويت عملت أستاذا زائرا في الجامعة الأمريكية لتدريس هذه المادة، وهذا قادني للدراسة في جامعة كينجستون في لندن لإنجاز الماجستير الرفيع في مجال الكتابة الإبداعية، وعدت الآن أدرِّس هذه المادة ولدي كتاب يدرس في أكثر من جامعة عربية عنوانه (مبادئ الكتابة الإبداعية).
أنت من التجارب الروائية والقصصية الرائدة على مستوى الخليج والوطن العربي، وشهدت الكثير من تحولات المشهد الخليجي على المستوى الاجتماعي بعد اكتشاف النفط. كيف تصف لنا ذلك؟
أرى أن الكتابة بقدر ما هي شخصية تنبع من داخل الكاتب، فهي أيضا وطيدة العلاقة بالمجتمع. فالكاتب لا يعيش على جزيرة منفصلة، وإنما يعيش متصلا بالواقع المعاش بكل تجلياته ومضامينه.
وبحكم كوني كويتيا وأنتمي إلى المجتمع الكويتي فقد عشت المراحل المتغيرة في الكويت منذ طفولتي. ترعرعت وسط حارة أو ما نسميه في الكويت «فريج» يغلب عليه الطابع العالمي، فقد كان لدينا جيران من مختلف الجنسيات العربية وغيرها. فالمرء يعيش في ملمح عالمي ويستمع إلى رطانات ولغات مختلفة، إضافة إلى كل اللهجات العربية. كما أنني درست على أيدي مدرسين عرب، وهذا يجسد جزءا من انتمائي للعروبة. وقد استمر الأمر كذلك حتى لدى دخولي إلى كلية الهندسة التي كنت ضمن الدفعة الأولى التي درست فيها، وبعد إنهاء دراستي الجامعية ودخولي إلى العمل الميداني في الموقع كنت محاطا بالعمالة من كل الجنسيات.
لذا فإنني قد عشت هذا الخليط المتحول بالأساس، المتحول في داخله والمتأثر بالتحولات التي تجري على حدوده وهو جزء من هذا العالم ككل، فمن الصعب أن تكون كويتيا وتنعزل عن تحولات العالم وأحداثه.
لذا فقد رصدت هذه التحولات في مختلف أعمالي الكتابية. ففي مجموعتي القصصية الأولى جزء من تجربتي الشخصية، معاناتي، ألمي حبي، وجعي، انكساري. فيها جزء من الأسرة. وفيها جزء من الحيط الصغير الذي يحيط بي، ثم ملمح الحارة وملمح الكويت ككل.
إنني بالأساس، وبشكل عمدي، اخترت أن أكون كاتبا كويتيا، أكتب عن الكويت والبيئة الكويتية، ولكن بملمح إنساني. لأن الكويت أتاحت لي أن ألتقي بعناصر إنسانية كثيرة.
وقد مرت الكتابة عن الكويت بمراحل معينة، لاسيما المجتمع الكويتي الحديث، خصوصا ما بعد النفط. فأنا ولدت عام 1958م، وأول شحنة نفط صدرت من الكويت عام 1946م، أي قبل 12 عاما من ميلادي، لذا فقد فتحت عيني على مكان فيه بيت خرساني وتكييف هواء وكهرباء، ولم أعش حياة ما قبل النفط، ولكنني بالتأكيد عرفتها من خلال أمي وأبي والأجداد وكبار السن ومعايشتهم لهذا الواقع.
هل لك أن توضح لنا جانبا من تعاملك مع هذا المعطى الاجتماعي والتاريخي وتوظيفه في أعمالك الإبداعية؟
تجسد ذلك في رواية «النجدي» التي ترصد تجربة وحياة علي ناصر النجدي «النوخذة» المولود في 1909م ومات 1979م أي عاش سبعين سنة. هذه الرواية تتحدث عن آخر اثنتي عشر ساعة في حياة النجدي، ولكنها ترصد سبعين عاما من تاريخ الكويت. المنعطف الذي عاشه المجتمع الكويتي من مجتمع بسيط يعتمد على البحر والبادية مرورا باكتشاف البترول ثم مجتمع ما بعد البترول.
المفارقة لهذه الحكاية الواقعية للرواية أنها تدور حول قصة ثلاثة أشخاص اثنان منهما أخوان من أبناء الهولي بالإضافة إلى علي ناصر النجدي. أحد الأخوين من أبناء الهولي توفاه الله وقد عثر على جثته في المملكة العربية السعودية، والآخر نجا بنفسه، بينما لم يعثر على أثر للنجدي، فهو ما يزال في البحر. هذا الرجل الذي عشق البحر في حياته ما يزال في مكان ما في أعماق البحر، وهذا ما تحاول أن تقدمه الرواية عبر الرمزية العالية، إذ أن النجدي في الرواية لم يمت وإنما ظل في البحر، بما يقول للقارئ بشكل أو بآخر بأن هذه الشخصية التي عشقت البحر كتب لها أن تبقى في البحر.
هذا يقودنا إلى الحديث عن حضور المثقف وارتباطه بحراك المجتمع على مختلف الأصعدة. كيف ترى حضور المثقف العربي ومدى قدرته على التأثير؟
حضور المثقف عبر التاريخ هو الحضور عبر الآخر أو حضور الظل. أما الحضور الأساسي فهو للسياسي وليس المثقف. الأنظمة هي التي تحكم وهي التي تقود وهي التي تقول الكلمة الفصل. وبقدر ما تكون الدولة منفتحة على الفكر والثقافة واحترام الإبداع يكون تأثير المثقف. لذا نجد تأثير المثقف في الدول الديموقراطية، والغربية تحديدا، كبيرا. لأن الكلمة التي يكتبها المثقف هناك مقروءة لدى مئات الآلاف، ولربما الملايين. وبالتالي يحصل الأثر.
وحينما تأتي إلى المجتمعات العربية تجدها مطحونة بواقع اجتماعي واقتصادي وسياسي صعب، مطحونة بدكتاتوريات وأنظمة حكم جائرة. المواطن العربي بالكاد يتنفس ويأكل، لذا قد ينظر إلى الثقافة والقصة والقصيدة والرواية واللوحة والمسرحية على أنها بطر أو ترف. صحيح أن هناك فئة تتعامل مع الثقافة، ولا ننكر وجود جمهور للقراءة، وهناك تظاهرات مثل معارض الكتب.
المثقف موجود ولكن ليس بالقادر على أن يصنع قرارا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن فعل الوعي الإنساني يأتي من خلال التراكم الكمي الذي يؤدي إلى تغير نوعي. أي أنه يتوجب علينا أن نراكم هذا الانفتاح والتسامح والمحبة والحرية وحقوق المرأة وحقوق الطفولة وحقوق الوافد عبر أجيال وعبر فعل جماعي، حينها يتحقق تأثير المثقف.
تشتغل في أعمالك السردية على التخييل الذاتي، وكنت سباقا في ذلك. حدثنا عن هذا الاشتغال ومدى قابليته للانتشار في مجتمعاتنا التقليدية؟
منذ روايتي الأولى وأنا أكتب ضمن مدرسة «التخييل الذاتي» وهي مدرسة فرنسية في كتابة الرواية، بحيث يكون الكاتب موجودا بسيرته الذاتية الحقيقية، لذا فحينما تقرأ (ظل الشمس) و(سمر كلمات) أو (الثوب) ستجد أن طالب الرفاعي موجود بسيرته الحقيقية مع زوجته وبناته وأبنائه وأصدقائه والكُتّاب والمحامين وبيئة عمله ومكتبه والمجلس الوطني، مع آلامه وانكساراته وخيباته وأوجاعه. لا أصور طالب الرفاعي كحالة من النرجسية والبهرجة، وإنما بواقعه الحقيقي كأي إنسان مهموم ويعيش لحظته التاريخية. وهذا التصوير يأتي متداخلا ومتماهيا مع الحكاية، وليس على الهامش، بل هو جزء من المتن الروائي.
وقد جاءت هذه القناعة بأن الكاتب ما هو إلا جزء من المجتمع، وأن الكتابة الروائية هي توثيق لحالة اجتماعية بالأساس.
في البدء لم يكن البعض يستسيغ هذه النبرة، أما الآن فهناك تسابق كبير من الكتاب الشباب نحوها. وأنا أزعم أنني حينما كتبت روايتي الأولى (ظل الشمس) عام 1996م، كانت تبدو غريبة في حينها، أن يقوم الكاتب بكتابة اسمه الحقيقي في النص، وذكر جهة عمله الحقيقية، وكنت حينها أعمل مهندسا في الموقع. لذا لم تكن مستساغة حينها، لاسيما وأن تبعاتها كبيرة ومؤلمة، فحينما يكتب المرء عن تاريخه فإنه بالضرورة يكتب عن تاريخ الآخر الذي يشاركه اللحظة الإنسانية. هذا الآخر ليس دائما لديه الاستعداد بأن يكتب عنه.
الكتابة وفق التخييل الذاتي نشأت في مجتمعات تحظى بقدر كبير من الحرية، وإيمان بحرية الكاتب. وحينما تنتقل بهذه الحرية إلى مجتمعاتنا الشرقية فإنك قد تدفع ثمنا غاليا جدا، وهذا ما أواجهه يوميا.
لديك فلسفة خاصة في اختيار عناوين أعمالك التي من بينها (سرقات صغيرة) ماذا تريد أن تقول من خلال هذا العنوان؟
هذا عنوان مجموعة قصصية وأنا متعلق جدا بالقصة القصيرة، وقد ترجمت هذا العشق قبل حوالي أربع سنوات بإنشاء جائزة للقصة القصيرة وهي «جائزة الملتقى للقصة القصيرة».
السرقات الصغيرة التي تتحدث عنها المجموعة هي أثمن السرقات التي يعيشها الإنسان، وهي لحظات الحياة. كيف يمكنك أن تسرق متعة. كيف يمكن أن تسرق لحظة تكون انتشاء تعيشه إلى سنوات.
والقصص في مجملها تنطلق من المجتمع الكويتي، وتمس شرائحه المختلفة مثل المرأة والرجل والبنت والمطلقة والعمالة الوافدة باعتبارها جزءا من البيت الكويتي. فأنا لا أتصور أن اكتب عن البيت الكويتي وأنسى أو أتجاهل حضور الآخر الموجود معنا. وهذا ليس تفضلا، وإنما هي محاولة للكتابة عن الواقع بصدق.
أسست «صالون الملتقى الثقافي» وترأسته، وانبثقت عنه جائزة وتحولت إلى الجامعة الأمريكية وأصبحت جائزة عربية. كيف تنظر إلى هذه التجربة الآن؟
لدينا في الكويت طقس كويتي خالص هو «الديوانية»، وهي مكان التقاء الأصدقاء، وقد كانت قديما تملكها عوائل بعينها في كل حارة أو «فريج»، وهي العوائل الأكثر ثراء وحضورا اجتماعيا.
«الملتقى الثقافي» هو صالون أدبي ويمثل امتدادا لتلك الديوانية في التراث الكويتي، ولكن بمفهوم حديث. وقد تأسس هذا الصالون عام 2011م، مع مجموعة من الأصدقاء الكتاب والمبدعين البارزين، الذين شرفوني بأن وقع الاختيار أن يكون منزلي هو مقر الصالون. كنا نجتمع كل أسبوعين، والآن نجتمع بشكل شهري، حيث نقيم جلسة حوارية يتحدث فيها أحد الكتاب في مختلف ميادين الإبداع والثقافة.
بعد سوات تمخضت عن هذا الملتقى، وبسبب عشقي للقصة القصيرة، جائزة الملتقى للقصة القصيرة، التي أستطيع القول إنها أصبحت معلما للقصة القصيرة العربية. لذا تم اختيارها للمجلس التأسيسي لمنتدى الجوائز العربية، وهي الآن في دورتها الرابعة، برعاية جامعة الشرق الأوسط الأمريكية.
ويبدو لافتا منذ أربع سنوات أننا في كل عام نشهد تنافسا كبيرا على الجائزة، فقد بلغت المجاميع القصصية لهذا العام 209 مجموعات، تتنافس على الجائزة في دورتها الرابعة التي أغلق باب المشاركة فيها أخيرًا. ونحن سعداء بأن مجموعة (نكات للمسلحين) للكاتب الفلسطني مازن معلوف التي فازت بجائزتنا عام 2016، قد وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة المان بوكر البريطانية، وهي واحدة من أهم جوائز العالم.
رغم أهمية الجوائز والتكريم للمبدعين إلا أنه كثيرا كما يثار اللغط حول مصداقية بعض هذه الجوائز وأهميتها. ما هو تقييمك لهذه الظاهرة؟
من حيث المبدأ أنا مع كل جائزة ترصد وتخصص لدعم الإبداع بشكل عام. وأرى أن مردود الجوائز إيجابي رغم اللغط الذي يدور حول بعضها، وكلها في النهاية تصب في خانة دعم الإبداع ودعم الكاتب العربي.
وهي أحيانا تعلي من شأن كاتب وتبرزه ولكنه سرعان ما ينطفئ، فليس هناك جائزة في العالم قادرة على أن تصنع كاتبا. الجائزة تكرم الكاتب ولكنها أعجز بكثير من خلق كاتب، فلا شيء يخلق الكاتب سوى التجربة الحقيقية القائمة على التراكم.
ختاما وددنا معرفة مشاريعك الإبداعية والثقافية القادمة؟
أنا انتهيت قبل أيام من كتابة رواية جديدة وقد دفعت بها للمطبعة، وهي بعنوان (حابي)، وهو اسم لأحد آلهة النيل ويحمل في تكوينه عنصري الذكورة والأنوثة معا. الرواية تتحدث عن التحول الجنسي في المجتمع الخليجي. وأزعم أن فيها شيئا من الجرأة، فهي تدور حول حالة كويتية حقيقية لتحول فتاة إلى ولد، وتتطرق إلى المراحل التي مر بها هذا التحول والمعاناة التي واجهتها الفتاة والصدام الاجتماعي وغير ذلك من الأمور التي ترصدها الرواية.
المشروع الآخر الذي يمثل لي أهمية كبيرة هو أنني أنشأت أخيرًا شركة بمسمى «شركة الملتقى الكويتي» وهي امتداد للملتقى وتتعامل مع كل ما هو إبداعي كالمشاريع الثقافية والمؤتمرات والورش الفنية في مجال الكتابة والنشر، أملا بأن يتوسع هذا الملتقى الثقافي الذي بدأ صالونا ثم انتقل ليكون جائزة وهاهو الآن يشكل مشروعا ثقافيا كويتيا عربيا.