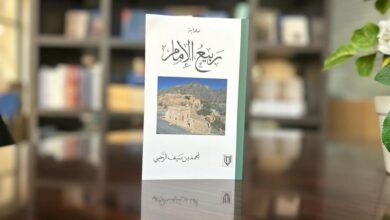مقالات
نهاية الجبارين

زاهر بن حارث المحروقي
السلطةُ المطلقة، وتطبيلُ وتصفيقُ الجماهير، هما المفتاحان الأساسيان اللذان يجعلان من الإنسان طاغيةً، ينازع الله سبحانه وتعالى في عظمته وفي ملكه. وعبْرَ التاريخ، قرأنا كثيرًا، قصصًا عن نهايات الجبارين والطغاة؛ بل إننا عايشنا بعض هذه النهايات في حياتنا – وهي حياةٌ قصيرةٌ قياسًا إلى عُمر الكون وإلى أحداث التاريخ -، ولكن مع ذلك فإنّ المتعظين قليلون، خاصة ممّن أعمتهم السلطة وأغراهم المال، فأفسدوا في الأرض قتلا وتدميرًا وتشريدًا وتجويعًا، وكأنّ قانون الله في الكون لن ينطبق عليهم، وكأنّ التاريخ قد توقف عند نهايات الطغاة السابقين فقط، وكأنّ مصير الطغاة الجدد سيكون أفضل حالا من السابقين.
قد يكون فرعون هو أشهر الطغاة في التاريخ، فقد وصل به الحال إلى ادّعاء الألوهية والربوبية؛ فاستخف قومه، وألغى عنهم ملكة التفكير، وجعل منهم عبيدًا، فما يراه هو، هو الصواب المطلق، «مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى»، «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطَاعُوْهُ، إنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنْ»؛ بمعنى أنّ الناس هي التي تصنع الطغاة، عندما يحيطون بهم فينافقونهم، ويتملقونهم ويتزلفون إليهم، رغبة في نيل رضاهم. وفي حالة فرعون، هذا ما أوصله إلى ادعاء الألوهية: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيها الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي»، فلا يملك أيّ جبّار أن يستخف بالناس، إلا لأنّهم خانعون وذليلون وفاسقون، فيما يصعب خداع الأحرار وأصحاب النفوس الحرة والأبية.
كانت نهاية فرعون نهاية أليمة، تُعلِّم كلَّ الجبارين، المصير الذي ينتظرهم؛ إذ أغرقه الله في البحر هو وجنوده، ونجّى عبده موسى. وفي تلك اللحظة فقط، لحظة انتهاء الطاغية، استجدى فرعون من الله الرحمة، ولكن بعد فوات الأوان.
وقد سبق فرعونَ في المصير الأليم، طاغيةٌ آخر هو النمرود، الذي تشير إليه الثقافة الرائجة، بأنه أول جبّار في الأرض؛ ادّعى الربوبية وأمر الناس بعبادته والسجود له، وعاث في الأرض فسادًا. ويذهب بعض المفسرين أنّ النمرود، هو الذي حاجّه النبيُّ إبراهيم عليه السلام، بعد أن ادّعى الربوبية، وبأنه بيده أن يُحيي ويميت. وعندما فشل النمرود في محاججة النبيّ إبراهيم عليه السلام، لفشله بالإتيان بالشمس من المغرب، أمر النمرود بحرق النبيّ إبراهيم عليه السلام بالنار، التي تحوّلت بردًا وسلامًا على إبراهيم. وعن مصير الطاغية وموته، ذكر ابن كثير أنّ الله أرسل إلى النمرود وجيشه، جيشًا من البعوض، بحيث لم يروا عين الشمس، وسلّطها الله عليهم، فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظامًا بادية، «ودخلت واحدةٌ منها في منخري الملك، فمكثت في منخريه أربعمائة سنة، عذّبه الله بها؛ فكان يُضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها». فهكذا كما تذكر كتب التاريخ، إنّ الله سلط عليه، أصغرَ مخلوقاته التي دخلت أنفه، فأزعجت رأسه بالطنين، ولم يكن ليهدأ إلا بعد أن يُضرب بالنعال على وجهه، حتى انتهى أمره. وسواء كانت القصة صحيحة أم غير صحيحة، فإنّ مغزاها يشير إلى ضعف الإنسان، وأنّ لله جنود السماوات والأرض، فلا ينبغي لأيِّ مخلوق أن يتجبَّر وينازع الله في ملكه؛ فنهايةُ النمرود، وكذلك نهاية فرعون، هي نهاية عادلة لمن ادّعى لنفسه ما لله، ولمن جهل أنه مخلوق ضعيف وله خالقٌ قويّ؛ وتانك النهايتان هما درسٌ لكلِّ طغاة الأرض يجب الاتعاظ بهما؛ إلا أنّ الأمر لا يتعلق بالنمرود وفرعون فقط، بل إنّ قصص التاريخ مليئة بمصائر الطغاة، لكنّ الوحي توقف عن النزول، وإلا فهناك قصص وعبر كثيرة، كان يجب أن تروى.
ولكن ما بال أقوام، أغلقوا أعينَهم عن مشاهدة الواقع، وتعاموا عن الاتعاظ بمصير الأولين، بعدما أغرتهم السلطة وأغواهم المال، فأصبحوا يثيرون الفتن في كلِّ مكان، وقاموا بأعمال يبرأ منها إبليس نفسه؟!. إنهم يعانون من عقدة النقص، وعندهم جنون العظمة، وهم لا يملكون مفاتيحها غير المال فقط.
إنّ مثل هؤلاء تنطبق عليهم الصفات التي ذكرها د. طه جابر العلواني في مقال نشره في موقع «التغيير» يوم 14 يناير 2012، تحت عنوان «نهاية الطغاة» حيث قال: «المستبدّ إنسانٌ ضعيف، يحمل مجموعة من الأمراض النفسية، تكمن وراء طغيانه واستبداده، وتكون تصرفاته الطاغية المستبدة ستارًا لأمراضه ومكوِّنات ضعفه، التي يحاول تغطيتها بذلك الاستبداد وما فيه من تظاهر بالقدرة المطلقة، والاستعلاء التام، والانفصال عن طبقة المستضعفين الذين يحكمهم. ومن الصعب على هؤلاء حتى حين تفاجئهم أعراضٌ بشريّة – كالمرض ونحوه -، أن يشعروا بأنّهم بشر ممن خلق الله، يعتيريهم ما يعتري البشر من ضعف، فلا يسلمون بحقيقة بشريّتهم، ولا يرون أنّ أمتهم يمكن أن تعيش بدونهم. إنّ المستبد تخدعه قوته وسطوته وحاشيته وتغشّي على بصره وقلبه، فلا يستطيع أن يرى أنَّه مجرد بشرٌ ممّن خلق الله، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، تنتهي إلى حفرة تضم رفاته إلى أن يأذن الله ببعثه».
****
للكاتب النرويجي هانز أندرسن، ( 1805 – 1875) قصةٌ تحمل عنوان «الأمير الشرير»، ترجمها إلى العربية حماد صبح. عندما قرأتُ القصة لأول مرة، وجدتُ نفسي أعيش تفاصيلها، وأسقطها على الواقع المعاش الآن، فإذا هي تكاد تتطابق مع الواقع، وكأنّ هانز أندرسن يعيش بيننا، ويستطيع كلّ من يقرأ القصة أن يسقطها على من خطر في باله.
تفاصيل القصة تقول إنه في سالف الزمان عاش أمير انصب قلبًا وعقلا على غزو البلاد الأخرى وإرهاب أهلها؛ فخرّب البلاد المغزوة بالنار والسيف، ووطىء جنودُه الغلال في الحقول، ودمّروا أكواخ المزارعين حرقًا. وكم من أم فقيرة هربت من كوخها الذي تصاعد الدخان من جدرانه، حاملةً رضيعها عاريًا بين ذراعيها، وكان الجنود يتعقبونها، فإذا عثروا عليها اتخذوها متاعًا لنزواتهم الشيطانية. وكان الأمير يرى في ما يفعله هو وجنوده عين الصواب. وتضاعفت قوته مع الأيام، وارتهب الناس من اسمه، وحالف الحظ أفعاله أيّما محالفة، وجلب ثروة هائلة إلى مملكته من البلاد التي غزاها، ورويدًا رويدًا تجمّعت في تلك المملكة ثروة عزّ نظيرها في أيِّ مكان آخر، فشاد القصور البديعة الحسان، والكنائس والقاعات، وهتف معجبًا كلُّ من رأى المباني البديعة والكنوز العظيمة: «يا له من أمير قوي»، دون أن يدروا شيئا عن البؤس الذي لا نهاية له الذي جلبه الأمير على البلدان التي غزاها، ولا سمعوا بالتنهدات والمناحات التي انبعثت من أنقاض المدن التي خرّبها مع جنوده. وكثيرًا ما كان ينظر في حبور إلى ذهبه وصروحه البديعة، ويقول لنفسه ما يقوله جمهور الناس عنه: «يا لي من أمير قوي. إنّما يجب أن أملك المزيد. يجب أن أملك أكثر ممّا ملكت، ولا يجب أن يشبه سلطان آخر سلطاني أو يقترب منه». وحارب الأمير كلَّ جيرانه وغلبهم. وفي النهاية صنع لنفسه تماثيل نُصبت في الأماكن العامة وفوق القصور الملكية؛ بل أحب نصبها في الكنائس، وفي المذبح تحديدًا، وهنا عارضه القسيسون قائلين: «أنت حقًا قويّ، لكن قوة الله أعظم كثيرًا من قوتك، وليس لنا قدرة على إطاعتك في هذا الأمر». فقال مغرورًا: «إذن سأحارب الله»، وأمر – تدفعه جلافته وصفاقته -، بصنع سفينة مهيبة يستطيع أن يطير بها في الجو، فصُنعت وأعدَّت إعدادًا فخيمًا، وأحيطت بآلاف مواسير البنادق. وجلس الأمير وسطها، وتحدّد عليه فحسب أن يضغط زرًا لتنطلق آلاف الرصاصات في كلِّ الاتجاهات. وشُدَّت إلى السفينة آلاف النسور، فانطلقت نحو الشمس في سرعة السهم، وما لبثت أن تناءت عن الأرض، وحجبها الضباب والغمام . ووالت النسور ارتقاءها في الفضاء، ثم أرسل الله – جل ثناؤه – أحد ملائكته الكثر للتصدي للسفينة، فأمطر الأميرُ الشرّيرُ الملاك بالرصاص آلافا، إلا أنه ارتد عن أجنحته المتألقة، وهوى هوي حَب البرد المألوف. ونبعت قطرة دم وحيدة من الريش الأبيض لأجنحة الملاك، وهوت فوق السفينة عند مجلس الأمير، واتقدت فيها، وأثقلتها كأنما هي آلاف الأوزان، وأنزلتها سريعًا إلى الأرض، فاستسلمت أجنحة النسور القوية، ودمدمت الريح حول رأس الأمير، وأطبقت عليه السحب. ترى أهي سحب الدخان الذي انبثق من المدن التي أحرقها الأمير مع جنوده؟!، واتخذت السحب أشكالا منكرة تشبه سلاطيع البحر، وترامت أميالا مِدادا باسطة مخالبها خلفه، وارتفعت تحكي صخورًا ضخامًا، وتدحرجت منها أعدادٌ هائلة، ثم إنها استحالت تنانين للنار نوافث. فقال الأمير مكابرًا: «سأحارب الله. أقسمت على هذا، ولا مناص من إنفاذ مشيئتي». وأنفق سبع سنين في صنع سفن عجيبة ليبحر بها في الفضاء، وصنع سهامًا من الفولاذ الصلب لاختراق جدران السماء، وحشد المحاربين من كلِّ الأقطار، وبلغوا كثرةً أنهم غطوا عدة أميال، حين اصطفوا جنبًا إلى جنب. وركبوا السفن، وقدم الأمير إلى سفينته، وعندئذ بعث الله تعالى، سرب بعوض، سربًا واحدًا فحسب من صغار البعوض، فزن حول رأس الأمير، ولسع وجهه ويديه، فغضب، وسل سيفه وضربه فلامس سيفه الهواء دون أن يصيب أيّ بعوضة. وأمر حاشيته بأن تأتي بأغطية نفيسة لتغطيته، ليمنع وصول البعوض إليه؛ إلا أنّ بعوضة استقرت في غطاء، ونفذت إلى طبلة أذنه ولسعتها، فجنّنه ألمُ لسعتها؛ فقطع الأغطية وقطع ثيابه، واطرحها بعيدًا. وراح يدور راقصًا أمام جنوده المتوحشين الأفظاظ، فسخروا من الأمير الذي أراد أن يحارب الله الذي لا غالب له، فغلبته بعوضة صغيرة.
****
استطاع هانز أندرسن، أن يصوِّر في قصته «الأمير الشرير»، نماذج حيّة من الأمراء الأشرار، الذين اتّخذوا من الشعوب عبيدًا لهم؛ معتقدين بأنهم بالمال الذي رزقهم الله به قادرون أن يسيطروا على الأرض بمن فيها وما فيها؛ لذا قاموا بحروبٍ عبثيةٍ في كلِّ مكان في الأرض، فأحرقوا الحرث والنسل، وأثاروا الفتن في كلِّ مكان، دون فائدة تُرجى من وراء تلك المغامرات؛ وكلُّ ذلك، بسبب إرضاء نفسياتهم المريضة، وبسبب وجود مطبِّلين ومزمِّرين من المنتفعين. وما لم يشر إليه هانز أندرسن، هو أنّ أميره الشرير يختلف عن الأمراء الأشرار الحديثين، بأنّ الأول كان ينطلق من مرض نفسي فقط، أما الأخيرون فإنهم «علاوة على الأمراض والعقد النفسية» فإنهم يخدمون أجندات خارجية لتدمير الأوطان حتى يأتي دورهم فيما بعد.
وإذا كان أمير أندرسن قرّر أن يحارب الله عسكريّا، فإنّ الأمراء الحديثين يفعلون ذلك، ولكن بأساليب أخرى تتماشى مع أساليب العصر. والنهايةُ التي اختارها الكاتب لأميره الشرّير، هي النهاية الواردة في كتب التراث عن نهاية النمرود؛ ولكنها هي نهاية كلِّ جبّار وطاغية، وإنِ اختلفت الأساليب والمصائر، فهذا هو عدل الله. ويبقى السؤال الدائم: هل من متعظ؟!