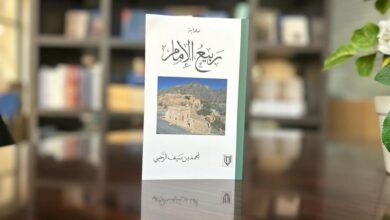مقالات
طريق التنازلات

زاهر بن حارث المحروقي
طريق التنازلات يبدأ – مثل أيِّ طريق نسلكه – بخطوة. وعندما يبدأ المشوار، فلن تكون له نهاية، سواء كانت هذه التنازلات على مستوى الدول والحكومات أم على مستوى الأفراد، إن كان في الحقّ، أو الحب، أو غيرهما من شؤون الحياة. والتنازلُ عادةً يجرّ إلى تنازل آخر، ويُغري إلى المزيد من الابتزاز من المتنازَل له؛ إذ أنّ الطرف المستفيد – خاصةً إذا كان انتهازيًا – غالبًا لا يقدِّر هذا التنازل؛ بل يعتبره حقًا مكتسبًا من حقوقه، ويحقّ له المزيد. وكثرةُ التنازلات قد تترك المرء محاصرًا في حالة الفرد، أو الدولة، إذا وصلت الأمور إلى نقطة لم يبق فيها شيءٌ يمكن التنازل عنه. وفي حالة الحب استطاع الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي مؤلف أغنية الأطلال الشهيرة لأم كلثوم، أنْ يصوِّر أبرع تصوير، التنازلات التي قدّمتْها المحبوبة لحبيبها، والحالة النفسية التي وصلت إليها بعد تلك التنازلات؛ فهي قد أعطت كلَّ شيء ولم تستبق شيئًا، ومع ذلك فإنّ قيد الحبيب أدمى معصميها، فكان التساؤل لم أبقي القيد وما أبقى عليّ؟! ثم لماذا الاحتفاظ بعهود لم يصنها هو؟! ولِمَ تبقى هي في الأسر وكلُّ الدنيا يمكن أن تكون لديها؟!. يقول إبراهيم ناجي:
أعْــطِـنِي حُـرِّيَّــتِـي أَطْـلِـقْ يَــدَيَّــا… إِنَّنِي أَعْطَيْتُ مَا ٱسْتَبْقَيْتُ شَيَّا
آهِ مِـنْ قَــيْـدِكَ أَدْمَى مِـعْــصَـمِـي… لِـمَ أُبْـــقِــيــهِ وَمَـا أَبْــقـَى عَــلَـيَـّـا
مَا ٱحْتِفَاظِي بِعُهُودٍ لَمْ تَصُنْهَا؟ …
وَإِلاَمَ ٱلْأَسْرُ وَٱلـدُّنْــيَــا لَـدَيَّـا؟.
ما يحصل في الحب يحصل في السياسة أيضًا؛ فالتنازل يؤدي إلى المزيد من التنازلات، خاصةً إذا كان الطرف المتنازِل ضعيفًا؛ فلا معنى لكلمة «التسامح» والتغنِّي بها إلا لدى الضعفاء، ولا معنى لعبارة «سلام الشجعان» إلا لدى المتخاذلين؛ فالسلام يفرضه الأقوياء حسب شروطهم. وفي القصة الرمزية التالية ما يشير إلى مشكلة التنازلات:
أمر أحد الحكّام الظلمة باعتقال مواطن وحبسه انفراديًا في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة دون أيّ سبب. فغضب المواطن وظلّ يركل باب زنزانته ويصرخ: «أنا بريء، لماذا تم اعتقالي وإيداعي السجن»؟. ولأنه تجرأ ورفع صوته قائلًا «أنا بريء» وأحدث بعض الضجيج، أتت الأوامر بنقله إلى زنزانة مساحتها متر مربع فقط. فعاود الرّجل صراخه، لكن هذه المرة لم يقُل أنا بريء وإنما قال: «حرام تسجنونني في زنزانة لا يمكنني النوم فيها إلا جالسًا»!. صراخُ المواطن مرةً أخرى أزعج سجّانه، فأمر الأخير بإدخال تسعة سجناء آخرين معه في نفس الزنزانة. ولأنّ الوضع أصبح غير محتمل، نادى المساجينُ العشرةُ مستغيثين: «هذا الأمر غير مقبول، كيف لعشرة أشخاص أن يُحْشروا في زنزانةٍ مساحتها متر مربع واحد؟ هكذا سنختنق ونموت، أرجوكم انقلوا خمسةً منا على الأقل إلى زنزانةٍ أخرى». فما كان من السجّان الذي غضب منهم كثيرًا بسبب صوتهم المرتفع، إلا أن أمر بإدخال خنزير في زنزانتهم وتركه يعيش بينهم.
جُن جنون هؤلاء المساكين، وأخذوا يردِّدون: «كيف سنعيش مع هذا الحيوان القذر في زنزانة واحدة، شكله مقزز، ورائحة فضلاته التي ملأت المكان تكاد تقتلنا، أرجوكم لا نريد سوى إخراجه من هنا». فأمر الحاكمُ السجّانَ بإخراج الخنزير وتنظيف الزنزانة لهم. وبعد أيام، مرّ عليهم وسألهم عن أحوالهم، فقالوا: «حمدًا لله، لقد انتهت جميع مشاكلنا»! (١).
عندما قرأتُ هذه القصة، التي أرسلها إليّ صديقي إبراهيم الوهيبي عبر الواتس آب، قفزت إلى ذهني مباشرةً القضية الفلسطينية؛ فما أشبهها بهذه القصة. فقد صرخ العرب مطالبين بفلسطين من النهر إلى البحر، أي بفلسطين قبل عام 1948. ثم طالبوا بأراضي 1967. ثم طالبوا بالضفة الغربية. ثم بغزّة، ونسوا الآن تمامًا فلسطين من النهر إلى البحر. ووصل الأمر بأن يندِّد البعض «فقط» بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكأنّ القضية هي وجود مقرّ السفارة الأمريكية. ولقد كانت القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى، ثم أصبحت قضية العرب فقط؛ ومع مرور الأيام أصبحت قضية الفلسطينيين وحدهم، ومع ذلك فإنّ الفلسطينيين انقسموا على أنفسهم، وبقيت القضية هي قضية حماس والجهاد الإسلامي. وعندما تظهر حركات المقاومة مثل حزب الله، يتم التآمر عليها بين العرب والإسرائيليين. وهذا يشبه تمامًا ما حدث في تلك الزنزانة، حيث أصبحت القضية هي المطالبة بإخراج الخنزير من السجن فقط، ونُسيت كلّ القضايا التي سبقت إدخال الخنزير إلى الزنزانة.
***
وليس بعيدًا عن قصة الخنزير والزنزانة، هناك قصةٌ رمزيةٌ أخرى من التراث العربي بعنوان «البقرة والخروف والديك»:
وقعت أحداث قصة البقرة والخروف والديك في قرية فقيرة تعتمد في معيشتها على حليب البقرة، وعلى ما يزرع أهلُها ويَجنُون من أرضهم. فذات يوم ضاع ديك القرية؛ فهبّ رجال القرية كلهم يبحثون عنه لأسبوعٍ كامل، إلى أن يئسوا من البحث، فعادوا إلى أعمالهم الاعتيادية، مطمئنين إلى أنّ خروفهم وبقرتهم بخير, إلا أبله القرية، الذي اعتكف تحت شجرة على مشارف القرية، وظلَّ يسأل المارة: هل لقيتم الديك؟! ويأتيه الجواب سريعًا: لا لم يتم العثور عليه, ثم ما أهمية الديك ما دام الخروف والبقرة بخير؟!، وما أهمية السؤال ما دام السائل هو أبله القرية؟!. وفي كلِّ مرة كان الأبله يضحك من أقاربه، لأنهم توقفوا عن البحث عن ديك القرية، ولأنهم استسلموا للأمر الواقع.
ذات يوم جاء من يعلن أنّ خروف القرية مفقود. فخرج نصف رجال القرية هذه المرة يبحثون عن الخروف المفقود؛ وبعد يومين أو ثلاثة عادوا بدونه، بعدما يئسوا مبكرًا من إمكانية العثور عليه أسوةً بالديك؛ فاستقبلهم الأبله عند مدخل القرية وسألهم بشغف: هل وجدتم الديك؟!. ظنّ سكّان القرية أنّ الأبله يسخر منهم، فانهالوا عليه رشقًا بالحجارة, إذ كيف له أن يسألهم عن الديك، بينما المفقود هذه المرة أهمّ كثيرًا من الديك المُزعِج، الذي لا يكف عن الصياح. لكنّ الأبله أصرّ على السؤال: هل وجدتم الديك؟!، ولما لم يجد غير نفس الجواب عاد يعتكف تحت شجرته ويواصل سؤال المارة عن الديك المفقود. ثم حدث ما لم يكن بحسبان أهل القرية على عكس الأبله؛ فبعد عدة أيام جاء من يعلن أنّ البقرة مفقودة. وهذه المرة خرج ربع رجال القرية فقط للبحث عنها, ولم يستمر البحث لأكثر من ليلة في محيط القرية. وفي الصباح عاد الرجال ليجدوا المجنون بانتظارهم تحت الشجرة ولما مرّوا به سألهم: هل وجدتم الديك؟!. عندئذ اعتبر رجال القرية سؤال الأبله إهانة لهم؛ فقرروا عقابه على ذلك بطرده من قريتهم. وفيما الاجتماع ينفض عن قرار الطرد، صاح أحد الحضور بالمجتمعين, دعونا نسأله عن سرِّ اهتمامه بالديك الذي لا يبيض ولا يكف عن الصياح, ولم يسأل أو يبدي اهتمامًا بالخروف أو البقرة. فجيء بالأبله ليَمثُل أمام اجتماع زعماء القرية؛ وسأله كبيرهم: كيف تجرؤ على سؤالنا عن الديك، بينما الخروف ضاع والبقرة ضاعت، وأنت لم تبد أيّ اهتمام بهما؟ لماذا تتمسّك بالسؤال عن الديك فقط؟! فأرغى الأبله وأزبد، وتحامل على نفسه ليجيب: لأنكم لو أصررتهم على إعادة الديك لما ضاعت البقرة!! (٢)
وهكذا؛ فإنّ التفريط في الديك، واليأس من البحث عنه، والاستسلام للأمر الواقع، كلّ ذلك كان السبب في ضياع الخروف والبقرة فيما بعد. ويمكن أن نسقط ذلك على واقع العرب اليوم، فيمكن أن يكون الديك فلسطين، وقد يكون العراق وقد يكون سوريا أو السودان أو حتى مصر. فقد أكِل العربُ عندما أكِل الثور الأبيض. فضياعُ فلسطين، كان مقدمة لضياع العراق. وضياع العراق كان مقدمة لتقسيم السودان. وتقسيم السودان كان مقدمة لتدمير ليبيا. وتدمير ليبيا كان مقدمة لتدمير سوريا. وتدمير سوريا له ارتباطٌ بالحرب على اليمن. وقصةُ الأسد الأبيض معروفة؛ حيث يُحكى أنّ أسدًا وَجد قطيعًا مكونًا من ثلاثة ثيران؛ أسود وأحمر وأبيض، فأراد الهجوم عليهم، فصدوه معًا وطردوه من منطقتهم… ذهب الأسد وفكّر في طريقة ليصطاد هذه الثيران، خصوصًا أنها معًا كانت الأقوى. فقرّر الذهاب إلى الثوريْن الأحمر والأسود وقال لهما: «لا خلاف لدي معكما، وإنما أنتما صديقاي وأنا أريد فقط أن آكل الثور الأبيض كي لا أموت جوعًا. أنتما تعرفان أنني أستطيع هزيمتكما لكنني لا أريدكما أنتما بل هو فقط.» فكّر الثوران الأسود والأحمر كثيرًا؛ ودخل الشك في نفسيهما وحب الراحة وعدم القتال فقالا: « الأسد على حق، سنسمح له بأكل الثور الأبيض». نقل الثوران الرسالة بنتيجة قرارهما وأخبراه بأنه يستطيع الهجوم على الثور الأبيض الآن. افترس ملك الغابة بسرعة الثور الأبيض وقضى ليالي شبعانًا فرحًا بصيده.
مرّت الأيام وعاد إلى الأسد جوعه. فتذكر مذاق لحم الثور، فعاد إليهما وحاول الهجوم فصداه معًا ومنعاه من اصطياد أحدهما؛ بل ضرباه بشكل موجع. فعاد إلى منطقته متألمًا متعبًا منكسرًا. قرر الأسد استخدام نفس الحيلة القديمة، فنادى الثور الأسود وقال له: «لماذا هاجمتني وأنا لم أقصد سوى الثور الأحمر؟». قال له الثور الأسود: «أنت قلت هذا عند أكل الثور الأبيض». فرد الأسد: «ويحك أنت تعرف قوتي وأنني قادر على هزيمتكما معًا، لكنني لم أرد أن أخبره بأنني لا أحبه كي لا يعارض». فكر الثور الأسود قليلًا ووافق بسبب خوفه وحبه الراحة.
في اليوم التالي اصطاد الأسدُ الثورَ الأحمر، وعاش ليالي جميلة جديدة وهو شبعان. لكن الأيام مرت وعاد الأسد ليجوع. فهاجم مباشرة الثور الأسود، وعندما اقترب من قتله. صرخ الثور الأسود: «أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض». احتار الأسد فرفع يده عنه وقال له: «لماذا لم تقل الثور الأحمر، فعندما أكلتُه أصبحتَ وحيدًا وليس عندما أكلت الثور الأبيض!». فقال له الثور الأسود: «لأنني منذ ذلك الحين تنازلتُ عن المبدأ الذي يحمينا معًا. ومن يتنازل مرةً يتنازل كلَّ مرة، فعندما أعطيتُ الموافقة على أكلِ الثور الأبيض، أعطيتُك الموافقة على أكلي».
هذه القصة بليغة جدًا وبها الكثير من العبر، وتصِّور حالة التشرذم عند العرب تصويرًا بليغا، فلن يسلم أحد من المصير الذي صار إليه العراق وغيره من الدول العربية، التي سقطت وتدمرت بسبب مبدأ «أنا ومن بعدي الطوفان»؛ فالطوفان جارف. ونحن الآن قد شاهدنا في حياتنا أكل الثور الأبيض ثم الأحمر، وربما شاهدنا أكلَ بعض الكباش ولكننا بانتظار أكل الثور الأسود.
***
هناك فرقٌ كبيرٌ بين الهزيمةِ العسكرية، وهزيمةِ الإرادة؛ فالعربُ هُزموا هزيمة عسكرية – هي الأكبر في مقاييس الحروب العسكرية – وذلك في يونيو 1967؛ ولكنّ الإرادة العربية لم تنهزم. فقد عُقدت في الخرطوم قمة «اللاءات الثلاثة». وصدر بيان القمة، وردت في الفقرة الثالثة منه وهي التالية: «لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل». لذا فرغم الهزيمة العسكرية، إلا أنّ الإرادة العربية كانت قوية، وكانت القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى والأساسية. وما حدث في حرب أكتوبر 1973، هو عكس ما حدث عام 1967؛ فقد حقّقت مصر نصرًا عسكريًا ما لبثت أن فرّطت فيه، وتصرّفت وكأنّها المهزومة، لأنّ الإرادة السياسية كانت مهزومة، وكانت القيادة السياسية قد خططت لمسار آخر بسبب لقاءات الرئيس أنور السادات وهنري كيسنجر الذي أثّر في الرئيس السادات أيّما تأثير، فأطلق السادات صيحتَه الشهيرة بأنّ أوراق اللعبة في الشرق الأوسط بيد أمريكا بنسبة 99%. وفي الواقع فإنّ السادات له دورٌ كبيرٌ في تسليم تلك الأوراق لأمريكا.
وستبقى قمة اللاءات الثلاثة في الخرطوم، قمة عزة العرب وكرامتهم، لأنها لم تستسلم؛ وبقي العرب فيها ثابتين رافضين مبدأ الاستسلام والتنازلات والتفاوض من موقف ضعف، رغم الهزيمة العسكرية.
١. القصة منشورة في مواقع مختلفة في النت بأساليب مختلفة. بعضها به زيادات وبعضها به بعض التعديلات، إلا أنّ الفكرة الأساسية والعامة تتفق مع المغزى العام للقصة. ويبدو أنّ القصة أساسًا من الأدب الروسي.
٢. نشر هذه القصة الكاتب جهاد المومني بعنوان «قصة البقرة والخروف والديك» في وكالة عجلون الإخبارية – 31 مارس 2013. شوهدت في الموقع في 14 يوليو 2018.