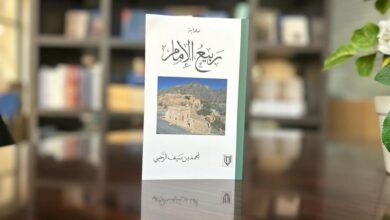مقالات
ليلى والذئب

زاهر بن حارث المحروقي
في طفولتي المبكرة، قرأتُ قصة «ليلى والذئب» التي هي أيضاً قصة «ذات الرداء الأحمر»(1). وأذكر أنّ هذه القصة شغلتْ عقلي كثيرًا، وكنتُ كلّما دخلتُ السرير تبدأ التساؤلات تثور في نفسي عنها وعن مغزاها؛ وكنتُ أتخيّل الحكاية كيف حدثت؟ وأتساءل في داخلي : كيف للذئب أن يتحدّث مع فتاة؟، وكيف له أن يلبس ملابس جدّتها؟، وكيف للفتاة ألا تكتشف أنّ التي أمامها ليست جدتها؟. كانت هذه التساؤلات تشغل عقلي أكثر من غيرها.
ورغم مرور أكثر من نصف قرن على قراءتي لقصة «ليلى والذئب» لأول مرة؛ إلا أنها بقيت في ذهني إلى اليوم، مع أني خلال هذه السنوات الطويلة، قرأتُ الكثير من الكتب خاصة الروايات والقصص. وقد بقي ذلك الحوار العجيب بين ليلى والثعلب وهو في فراش الجدّة يشغل تفكيري:
يا جدّتي.. لماذا صوتك ضخم؟!
لأحيّيك بطريقةٍ أفضل.
يا جدّتي.. لماذا كبُرتْ عيناك؟!
لأنظر إليك بطريقةٍ أفضل.
يا جدّتي.. لماذا كبُرتْ يداك؟!
لأعانقكِ بشكلٍ أفضل.
يا جدّتي.. لماذا كبُرتْ أذناك؟!
لأسمعك أكثر.
يا جدّتي.. لماذا كبر فمُك؟!
لآكلك بشكلٍ أفضل.
هنا قفز الذئب ليأكل «ذات الرداء الأحمر»، وينام بعدها في سرير جدّتها بهدوء.
ربما ما جعل هذه القصة ترسخ في ذهني، أنني أثناء قراءتي الأولى لها، كنتُ أعيش وعائلتي في قريةٍ أفريقيةٍ نائيةٍ تحيط بها الغاباتُ من كلِّ حدب وصوب، لذا كان وقعها على ذلك الطفل أكبر.
ذات يوم، كنتُ أتصفح شبكة الإنترنت، فوقعَتْ عيناي على قصة «ليلى والذئب»؛ وقد كنتُ كمَن وقع على كنز ثمين، إذ أعدتُ قراءة القصة أكثر من مرة؛ وحاولتُ أن أكتشف ما الذي استهواني وأثارني فيها عندما كنتُ طفلاً، وما هو المغزى منها؟.
عمومًا؛ فإنّ أدب استنطاق الحيوانات هو أدب معروف له جمهوره ومتابعوه؛ ولعل كتاب «كليلة ودمنة» لمترجمه عبد الله بن المقفع هو أشهر كتاب عربي تناول أدب الحيوان(2). وهو الكتاب الذي قرأته أيضًا في وقت مبكر من حياتي، وإن لم تعلق قصصه في ذهني مثل قصة ليلى والذئب. غير أنّ الحكاية على لسان الحيوانات ربما تكون قد عُرِفتْ عند العرب قبل هذا الكتاب بقرون طويلة. وهذا ما يؤكده الكاتب التونسي المنصف الوهايبي في مقال له عن «أدب الحيوان»، فــ «لئن كان كليلة ودمنة لابن المقفّع مركز الاهتمام الذي يعود إليه جلّ الدّراسات التي تتناول هذا القصّ لدى العرب؛ فإنّ ذلك لا يعني بالضّرورة كون العرب لم يعرفوا الحكاية على لسان الحيوان إلاّ في الكتب التي تدور في فلك القرآن، أو في القرن الثاني. وإنّما عرف العرب هذا النمط، منذ العصر الجاهليّ، كما تشهد بذلك قصص الحِكَم والأمثال الواردة بتفاوت في أمثال المفضّل الضّبي (ت 170 هـ)، وفي «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (ت 395 هـ)، وفي «مجمع الأمثال» للميداني (ت 518 هـ). ومع ذلك تبقى لكتاب كليلة ودمنة مكانته، خاصّة عند فلاسفة المسلمين؛ مثل ابن رشد وابن سينا»(3).
***
من خلال مقالاتي الأسبوعية التي أكتبها في جريدة «الرؤية» العُمانية، كنتُ أحيانًا أتناول بعض القصص التي يكون الحيوان فيها هو البطل؛ حيث يحكي ما لا يستطيع أن يحكيه البشر. وكانت تلك المقالات تجد القبول الحسن عند بعض القراء، الذين تواصلوا معي مشكورين. ولعل أبرز المقالات التي تناقلتها المواقع العربية عبر الشبكة العنكبوتية، هو مقال «التسريبات الخليجية وحكاية العقرب والضفدع»، والذي نشر في الرابع عشر من تموز – يوليو 2017. ذكرتُ فيها أنّ قصة «الضفدع والعقرب»، تشير برمزيتها، إلى واقع الدول الخليجية بعد معركة نشر التسريبات التي قامت بها الدول الخليجية ضد بعضها البعض؛ فيُحكى أنّ ضفدعًا كان يستعد لعبور النهر؛ وإذ به يجد عقربًا يطلب منه أن يساعده في العبور. فقال الضفدع: لماذا لا تعبر بمفردك؟. فأجابه العقرب: أنا لا أعرف السباحة, ولكي أعبر النهر يجب أن تحملني فوق ظهرك حتى نصل سويًا. فقال الضفدع: ولكنك مشهور بأنك تلدغ كلَّ من تقابله، فهل يُعقل أن أسلمك ظهري وجسمي كله, وأين، في النهر؟!. فلو لدغتني سأموت ونغرق معًا. فأجابه العقرب بثقة: لستُ غبيّا لأفعل ذلك, فحياتي بيدك!. هنا اقتنع الضفدع ووافق أخيرًا على مساعدته؛ وتسلق العقرب ظهر الضفدع وبدآ في العبور؛ ولكن في منتصف الطريق فوجئ الضفدع بالعقرب يغرس أرجله السامة في ظهره, فخارت قوى الضفدع, وبدأ الاثنان يغرقان تدريجيّا. وسأله الضفدع وهو يبكي: لماذا فعلتَ ذلك؟، ألم أقل لك إننا سنغرق معًا لو لدغتني؟، فأجابه العقرب: يا عزيزي أنا عقرب, وأنت تعرف ذلك, ولو لم ألدغك وأخدعك, لما استحققتُ أن أكون عقربًا؛ فغرق الاثنان, فيما لم يستفد العقرب من غرقه, سوى إثبات أنه عقرب.
وهكذا فإنّ إسقاط قصص الحيوانات على الواقع، فنٌ من فنون الكتابة منذ عصور بعيدة، لما له من أثر على المتلقي.