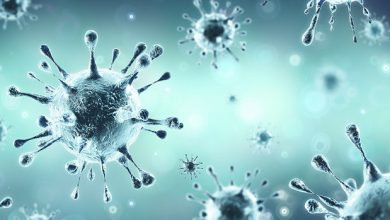الثقافي
محمد علي شمس الدين: الشعر يبدأ حيث ينتهي التاريخ والفلسفة

منذ ديوانه الشعري الأول (قصائد مهربة إلى حبيبتي آسيا) مرورا بكل دواوينه مثل (أميرال الطيور) و(أناديك يا مكلي وحبيبي) و(الشوكة البنفسجية) و(النازلون على الريح)، وغيرها من الأعمال الكثيرة، طرح نفسه شاعرا طليعيا بامتياز واستطاع أن يحجز مقعده في الصفوف الأولى بين شعراء العربية، مشكلا تجربة شعرية إبداعية استثنائية، لها نكتها اللبنانية الجنوبية التي تنفتح على المنجز الحضاري والشعري العربي والعالمي قديمه وحديثه، لاسيما الصوفي والأسطوري. عايش تحولات المجتمع العربي عبر عشرات السنين حتى بات ذاكرة معرفية تختزل كل هذه الأحداث، تتفاعل معها، وتتألم لها، وتعيد إنتاجها شعرا فاتنا لا يشبهه إلا هو. إنه الشاعر العربي اللبناني الكبير محمد علي شمس الدين. التقته (التكوين) على هامش ملتقى القاهرة الدولي الرابع للشعر العربي، خلال نوفمبر 2016م، فكان هذا الحوار.
حوار: حسن المطروشي
* نحن نعرف الكثير عن محمد علي شمس الدين الشاعر، ولكن هناك الكثير من الخبيء عن محمد علي شمس الدين الشاعر الإنسان، بدءا من مواطن طفولته ومرابعه الأولى. نود أن نبدأ حديثنا عن هذه العوالمة البعيدة؟
** أنا ابن بيئة رعوية في الجنوب اللبناني، نشأت في بيت جدي الذي كان هو شيخ القرية، وكان مزراعا في الوقت نفسه. أما أمي فقد كانت أشجار الكروم التي أجري فيها على هواي عاري الصدر، وحافي القدمين في كثير من الأحيان، وكنت مغرما بالمشي حين تهب الريح. لم أذكر لك أبي وأمي، لأني عرفت أمي حين ماتت فقط، فأبي وأمي كانا يعيشان في فلسطين. وكانت نشأتي الأولى مع العناصر، ومع بعض الحيوانات في المنزل، مع شجرة التين ومع الصوت الذي كان يصدح به جدي مترنما بالأشعار القديمة التي كان يغنيها غناء.
كان صوته حزينا كربلائيا، إذ كانت تقام الطقوس الكربلائية في قريتي الجنوبية، وكنت دائما رفيق الجد في هذه الطقوس. فأنا ابن الصوت وابن العناصر. وكانت لدى جدي مكتبة فيها كتب الجاحظ وأبي حيان التوحيدي وديوان الشريف الرضي وديوان المعري وديوان المتنبي. وأول من قرأت اثنان، هما التوحدي في المقابسات وقرأت الشريف الرضي، ولكنني بعد سنة، وكنت في الثالثة عشر من عمري، قرأت المعري واستهواني كثيرا. وأول قصيدة كتبتها كانت (على مدارج أبي العلاء المعري). وبالتالي اختلطت هذه العناصر في نفسي باكرا، ممثلة في الصوت الشجي وعناصر الطبيعة، حيث تتداخل دائما في قصيدتي:” تهب الريح من فلواتي الجرداء”، وألفتي بهذه البيئة كأنها الجنة. لقد كانت طفولتي سعيدة.
* في هذه البيئة القروية الفطرية .. هل زاولت المهن التي يزاولها الناس هناك، مثل الفلاحة والرعي وغيرها؟
** كنت أحتك دائما بالتراب، وقد مارست زراعة التبغ. وكانت لنا جارة صغيرة، أصغر من سنا، أحببتها، وكانت لنا جارة أكبر مني سنا، وقد أحبتني، حيث كنت صغيرا، فما أذكره أن أول أحاسيس الجسد لدي تفتحت بين يدي هذه المرأة التي تكبرني سنا، وقد كتبت ذلك في ديواني (النازلون على الريح).
* هذا يقودنا بعلاقتك بالمرأة بدءا من الأم الغائبة والعاشة التي تكبرك سنا والمعشوقة الأصغر سنا مرورا بكل عوالم النساء في تجربتك .. كيف تشكلت العلاقة بعد ذلك بالمرأة؟
** هذه التحولات في أغلبها جسدتها في شعري، وهناك أطروحة ماجيستير حول النساء في قصائدي. هذه العلاقة هي مزيج بين الأم البعيدة، والأنثى القريبة جدا على مستوى الجسد منذ الطفولة الباكرة، يضاف إلى ذلك انحيازي الفطري للأنثى، هذا الانحياز سببه الفقدان، وإذا أنت فتحت القصيدة وحدقت فيها ستجد انخطافا ميتافيزيقا، ستجد أنثى حقيقية، وستجد العناصر تتحرك في داخل القصيدة.
* نشأتك قروية بامتياز وقد تجلت هذه العناصر شاخصة في قصائدك .. فما الذي تبقى من هذه الأطلال في ذاكرتك وشعرك؟
** نعم هذه العناصر ما زالت تحضر ولكن بصور متطورة، ابتداء من المحسوس الملموس في اتجاه السحري. تبدأ قصائدي بما هو ملموس (ناوليني حذائي وقلبي، ناوليني العصا وقربة ماء الحياة)، ولكنها تنتهي بأن تغيب في الغيب. وأن من خلال هذه النشأة الروحية الدينية، ومن حيث الصوت الشجي وقرآن الفجر، إذ لا أنسى قرآن الفجر في القرية، ومن حيث ارتباط هذه الحياة بعناصر تمزج الدين بالسحر، حيث كان يقصد منزلنا النساء حين يمرض أحد أفراد العائلة، إذ كان الشيخ يمثل الطبيب تقريبا، إنه الطبيب الروحي. وحين تفقد غنمة أو ماعز فقد كان هو المرجع أيضا، إذ كان ينعقد عنها فكوك الوحش من خلال استخدام سكين معينة، يفتحها ثم يغلقها على نحو معين، وبالتالي ينعقد فم الوحش عن أكل الحيوان الضال. وكان هو أيضا يراقب الولادات، ويرافق الموتى إلى المقابر، وكان يقرأ بصوته الشجي الحزين الأشعار والأوراد، وكانت روحي كأسفنجة تتشرب ذلك وتجسد في أشعاري، وحين يتم النظر الآن إلى ما كتبت من أشعار ستجد هذه العناصر متحولة، ولكنها هي هي التربة الأولى لكل نبات شعري نبت في حياتي.
* لديك صلة عميقة بالدين، وشعرك صوفي روحي، ألا توجد أسئلة مجاورة لهذا اليقين الديني، تؤرق المفكر والشاعر الكبير؟
ـ نعم لدي أسئلة لا شك .. فمن يقرأ قصائد مثل (دموع الحلاج) سيجد أن حاجتي للحنان وإحساسي بأنني أحيانا منسي أو مرمي يجعلني كقشة لا تستطيع أن تقطع صلتها بالريح. وحين تقرأ (أعليت دموعي كيما تبصرها يا الله، وقلت أعيد لك الأمطار، فلتنشر غيمك حيث تشاء فإن الغوث يعود إليك وإن الحزن يعود إلي)، فهذا عتاب رقيق جدا مع الحبيب، فإقول له (أنا لست قويا حتى تنهرني بالموت، يكفي أن ترسل في طلبي نسمة صيف فأوافيك، وتحرك أوتار الموسيقى فأموت وأحيا فيك. هذا ألمي، هذا ألمي، خفف من وقع جمالك وفق فمي). إذن أنت ترى هنا أنني مستسلم لجمال الألوهة، ولكنني قلق، من حيث ينبغي أن أكون مطمئنا. أنا ليست لدي الطمأنينة. فحين ألبس حالة العرفان والتصوف فانا لا ألبسها بكامل ما تعطيه أو ما توحي به من أحوال مواقف. أنا لست درويشا، ولدي قلق ديني عميق في نفسي، كان ولا يزال، ويجعلني كمسافر في مركب غير مطمئن للرياح، وغير مطمئن تماما إلى أين يذهب. أنا وجودي من صغري، وفي شعري ألوان من العدم (يأتي من جهة البحر ومن جهة الصحراء طفل أبيض بقنابل ضوء فوسفورية، بحمام أو بطباشير ويدوّن فوق اللاشي هواجسه، لاشيء).
إذن هذا المزيج من العدم مع الانخطاف مع الإحساس بحضور الألوهة بين الحب والخوف هو ما يشكل كيمياء روح قصائدي، وهي مسائل، أولا أحسست بها باكرا مع الوعي، وثانيا أنا أعتبرها من صلب المعرفة القرآنية، بمعنى أن شعري مرجعيته قرآنية ومن خلال المعرفة القرآنية وصلت إلى هذا المنحى. فبالنسبة للقرآن كل الوجود يولد وينتهي في رمشة عين، التاريخ كله أو الحياة الدنيا محض خيال، التاريخ كله عدم ممتلئ، وغالبا ما يعطيك الأمثلة عن قرية أصابتها سحابة امطرت فنمت فإذا هي خاوية على عروشها. فلا توجد فواصل بين نمو القرى أو العمران وبين أن تصبح خاوية على عروشها. إذن هذا الفراغ الممتلئ هو ما يحرك أشعاري.
* منذ البدء طرحت نفسك شاعرا طليعيا نخبويا مثقفا، وتتجلى ثقافتك في منجزك الشعري وكتاباتك المختلفة. كيف تتعامل مع مفردات التاريخ والفلسفة في قصيدتك؟
أنا معني بالثقافة في معناها الأوسع. فأنا قارئ في التاريخ ولدي دكتوراه في هذا المجال، وليسانس الأدب العربي قديمه وحديثه، واختصاصي حقوق. فكل هذه المعارف مكنتني أن أصنع لنفسي جملة في الشعر، ولي في هذا الموضوع مقولة قوية، أن الشعر يبدأ دائما حيث ينتهي التاريخ وتنتهي الفلسفة، أي أن الشعر هو التحويل. فأنا كقارئ تاريخ أعرف أن الحجاج بن يوسف كان ظالما، ولو قلت ذلك بنص إعلاني لما أضفت شيئا، ولكان المؤرخ أهم مني، ولكني أنا الشاعر اخترعت الصورة واللغة، لكي أقول على لسان الحجاج (توضأت بالدم لم يقبل الماء وجهي). فأنا هنا أكتب شعرا فوق التاريخ. الفكرة الفلسفية أيضا هي مندرجة في مصهر شعري، من الصور والاستعارات والحوم حول المعنى، أو الطيران حول المعنى وليس الولوج له مباشرة. لذلك أصبحت أرى الشعر خلاصة الحياة والثقافة والتأمل، وأرى في الشعر باستمرار أنه جرح من أقدم الجروح في روح الغيب.
* أخيرا .. كيف يعيش محمد علي شمس الدين الشاعر ويقضي أوقاته الآن؟
** أنا لست تراجيديا ولكنني قلق، أعيش تقريبا بشكل من أشكال العزلة النسبية عن ما أعتقد أنه يلوث روحي، فأن قليل الجلوس في المقاهي وأماكن الثرثرة المجانية، وعلاقاتي مع الناس يسودها شرف الحياة. وقد تبين لي أن الحياة في مساراتها مهما كنت حذرا ومهما كنت رائيا فدائما ما تأتيك ببعض المفاجآت، لا أدعها تسيطر على روحي، ولكن لابد من انعكاساتها، وكما قلت في قصيدة (كلما أدركت ما كانت تقول الشجرة، خذلتني سوسة نائمة في الثمرة). أي دائما هناك مفاجآت ولكن عليك أن تكيف أفكارك وحياتك تبعا لذلك وتبعا لقسطاس تعيشه وأن تكون عادلا، فسبب الحروب وتعاسة البشر هو ميزان العدل المكسور، وهي مسألة وجودية بالنسبة لي وتؤدي إلى سؤال ميتافيزيقي جوهري في شعري، فأنا دائما أبحث في قلق كيف يمكن أن يستقيم ميزان العدل المكسور.
نشر هذا الحوار في العدد (18) من مجلة التكوين..