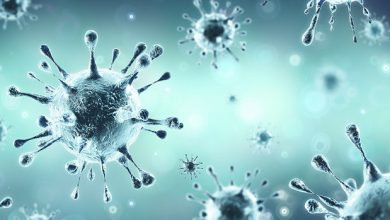الثقافي
في مقام الصحو

محمد بن سيف الرحبي
لم أكن على بيّنة، أجوس في الشتات بحثا عن شيء ما لم أنتبه له سابقا، يشبه ما لا يمكن تبيّنه، يشي بما عليه الأشياء من حولي، وقد اختلطت مسالك وخطوات، وما تراكم على المرايا من غبش، فلا القدمان تعرفان أي مسلك تضعان عليه خطوتهما التالية، ولا المرايا تستقبل الوجوه.. فتبتهج مرآة ويتأنّق وجه.
أمسح بيدي الصورة، فتترنّح على سطح المرآة، لتبدو واضحة بما يكفي، لعلّي أتبيّن وجهي، مع أن التشظّي يأخذ من سكينة الأصابع، فيغدو للغبش لون أحمر، يعيدني إلى ذات البؤرة التي أغرق فيها، وأدور، وأفتّش عن مسلك يغدو سائرا على نحو ما، بطريقة مبهجة إلى النهاية السعيدة، أو تلك التي تسمى بـ “حسن الخاتمة”.
وقد رأيت فيما يشبه الصحو، ولم أكن على مقربة من الإغفاء أبدا، أن الأرض مدّت تحت قدميّ، وألقت ما فيها من هواجس وخوف، حتى إن روحي تخلّت عمّا كانت تقبض عليه من حلم شفيف، وكنت كموجوع أحكم قبضتي متمسكا به ومتدثّرا، علّه يخفّف عنّي غلواء عمر انتكس على حين لم يفطن إلى أوانه بما يكفي.
منذ عدة أسابيع لم ألتق حبيبتي، لا في الصحو ولا في المنام، ومع أنّي لا أكاد أغمض عيني إلا أراها، تهجرني ساعة أن يهبط عليّ ذلك الستار الأسود، على الأغلب يتأخّر معاندا حتى مطلع الفجر، فتشتبك في فمي صنّارات عدّة تجتذبني في ذات اللحظة إلى اتجاهات شتى يقف عليها صيّادون ماهرون في جذب من تنشب الصنّارة في حلقه، أنهض متعرّق الروح ومجهد القلب، وملح الأرض يتكدّس على شفتي، كما وصفت ذلك يوما لحبيبتي حينما اجتهدت أقنعها بمنحي شفتيها فأرتوي.
نهضت على سعال يكاد يخرج قلبي من مكمنه، وهو يحتمي بتلك العظام المكوّنة لقفصي الصدري، وتأمّلت من حولي قفصي الكبير، فعليّ المكوث فيه قدر ما يأمنني ممّن خلف هذه الجدران.
نهضت من يقظتي المباغتة، أحاول أن أرتدي لباس النوم بأسرع ما يمكن لأهرب من يقظة تحتاج إلى ظل، فشمسها محرقة، والجدران تحيطني عدة أسابيع، والضوء لا يكاد يأتي عبر النوافذ، وإن أضاء الغرفة بما يكفي ويزيد عليها في صيف ملتهب، إلا أنه ليس هذا ما أريده على وجه التحديد، بل شيء ما يقبض عليه مارد هناك يمنعه عنّي، فأقبع في ظلمة، وتحرقني شمس!.
-
لو تعود لحلمك، فتغيّر أقدارك فيه.
قلت لنفسي، وأجابتني نفسي:
-
الأحلام لا تغيّر الأقدار مهما عدنا للغفو سنين تالية.
لم أنتبه لنفسي إذ أحدّثها، صوتها يتسلل أحيانا ليسلّيني قليلا، ولم أكن أروي حلما، بل ما رأيته في صحوي على سرير مخملي، مع أني أكاد ألمس الشوك إبرا تنبت مما أسفلي وما فوقي، يا إلهي، هذه الذات تجاورني وكأني بها حبيبتي التي أشتاق إليها، ولأبوح لها بشيء مما رأيت.. وحتى ما لم أر!
-
لكنه لم يكن حلما في الأصل.
-
بل، هو الصحو أو ما يشبهه.
كيف كشفت نفسي دون أن أتمكّن من تحديد حالة الوعي التي أنا عليها؟!، لأكون مسؤولا عن تصرفاتي؟!، وفي جرابي ما فيه من أفاعٍ لا تنتظر بالضرورة نايا لتخرج راقصة، فيضحك الجمهور، وينفضّ جمعهم على فتات بالكاد يغنيني من جوع أو يأمنني من خوف.
أنا الحاوي في جراب صدري أفعى تفحّ، وترقص، والجمهور يتابع، يرتدي الكمامات ويتابع، يرتدي القفازات ويتابع، يضع المعقمات ويغسل يديه بالصابون ويتابع، مذيع نشرة الأخبار يرمق النظّارة أمامه ويتابع، محرر الصحيفة يحسب الأرقام بدقّة ويتابع، ووصولا إلى الجالسين في الكراسي يجيبون على الأسئلة، ولا تخفّف أجوبتهم من فراغات المصيدة التي أدور فيها.
حينها أصبت بحالة من عاد لوعيه للتوّ، كنت بين مسارب عدّة، لكنني شعرت بأني اتخذت خطواتي نحو مسرب لا أريده، فقلت لنفسي: لأغفو قليلا، فربما في الحلم ما يتيح لي فرصة أخرى لأعيد حساباتي من جديد.
وكنت على وشك أن أرى تلك البقعة الهائلة من جديد، تلك التي تتفرع منها مسارب لا تحصى، وخشيت على نفسي أن أضيع كعادتي، وأن لا تأخذني قدماي…..، مهلا، لماذا أترك لهاتين القدمين دوما مهمة أخذي وإرجاعي؟، فحدّثتني نفسي الأمّارة بالحب أن أتبع قلبي..
قالوا من يتبع قلبه لا يضل..
إنما لم أأمن هذا القلب الضالّ يوما، كأنه مفطور على الانحناء، وعلى الحنين، إن سمع إحداهن فرّط في تماسكه، يخرج من صدري ويتبعها، وأبقى سنين أتبع قلبي الأسير، لعل آسرته تعيده إلي، أو أنا أتبعه، لكنه يعود إلى سيرته الأولى، فلا ينتبه إلى نزفه، ولا إلى نزفي.
حاولت إبعاد الجدران قليلا، لأستطعم الحرّية، أن أتمكّن من القول لجاري “صباح الخير” دون أن يتوجّس قلبه، نعم قلبه، وليس (ربما) جميع كيانه، منّي، من هذا الرجل الوبائي، وأخاله أنه يسمع سعالي كبقية الجيران، ويتحسّرون على أني جاورتهم، وأن هواء المنطقة جميعه مغلّف برذاذ عطسي، في الحارة قنبلة نيتروجينية مفتوح مبسمها، ملقاة في صدري، معكّرة صفو أجواء لم تتعكّر طوال حياتهم.
انتبهت: لم يكن إلا حلما، سأنهض، سأكتشف أن العالم ليس كالذي رأيته في كوابيسي، هذه المدينة ليست لي، وشوارعها عبث فيها مصمم عبر برامج حاسوبية أخرجت الحياة منها، ما يحدث محض فيلم طويل، المخرج طلب من الممثلين تغطية نصف وجوههم السفلى بأقنعة يبدو أكثرها زرقاء، فلا يتصافحون، ولا أحضان بين العشّاق، وسيأتي مشهد النهاية فيه على نحو فرائحي، وسأطفئ التلفزيون، وسأقول لأي كائن قريب منّي، ولو لنفسي “تصبحين على خير”، وأحاول أن أزيح بعض الشوك من تحت جفنيّ لأغفو، غفوة تتداخل مع غفوة، نوما يخالط نوما.
صحوت من نومي الذي كان داخل النوم، ورأيت أن النهايات لم تكن سعيدة، وحاولت، وكنت في حالة اللاصحو تلك، أن أقنع نفسي بمواصلة السير فيه لأتمكن من تعديل المشاهد، بصياغة أخرى لما رأيته، والعودة إلى مفترق الطرق على الأقل، وفي زحفي نحو تلك المحاولة صحوت من النوم الذي كنت أغلّف به حلمي المتسرب في حلم آخر، ونسيت، من فزع، أن أستفيق من ذلك الذي يقبع داخله.
حملت نفسي على مشقة أعمق، أن أدفن عيني مرة أخرى في لجّة الغياب، لأغلق باب الحلم الذي تركته مفتوحا، وكان باب البيت به متسع لأفتح أمام قدمي مجال الرؤية، خارجا نحو الطريق الممكن، وكان الناس يرجمونني، يهربون منّي، أفزعتهم رؤية وجهي عاريا، لم تكن تداري سوءته ورقة من كمامة قماشية، وكانت أصابعي مصابة بالعري، فحاولت أن أدسّها في جيبي مخافة اكتشاف خدشها للحياء العام، لكنني شعرت، وإذ هممت، أنها ستخرج سوداء، كأنما مسّتها نار.. فاحترقت.
وفي لحظة انبعاث دخان عدت إلى رشدي، وإلى تجاويف الأحلام تنغلق جميعها، وإلى خلف بابي الموصد عدت ألقم قدميّ ما كنستهما من الدرب، وأسمع ضحكة المفتاح تدغدغ ثقب القفل، وتواريت خجلا من الجدران.