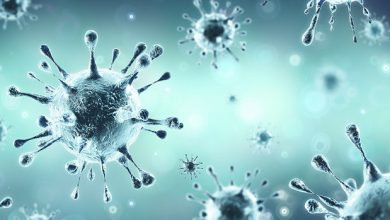الثقافي
مستقبل الشعر .. سؤال البقاء وقلق الانقراض

رغم اختلافهم على تحولات الشعر وأشكاله وآفاقه القادمة، إلا أنهم جميعا اتفقوا على بقائه ومستقبله. لا لشيء سوى أنه الشعر، ذلك الجرح الأعمق في الروح منذ أقدم العصور، وهو الوسيلة التي لجأ الإنسان إليها والمظلة الآمنة التي فزعت إليها البشرية عبر تاريخها المديد. ولا عجب أن تتساءل البشرية دائما عن مستقبل الشعر. فهو سؤال منبعه الخشية العميقة على هذا الكائن الجميل الذي رافق الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الآن.
في هذا الاستطلاع تستقرئ (التكوين) آراء مجموعة من الشعراء العرب البارزين، حول الشعر وما يتعلق به من سؤال البقاء وقلق الانقراض، فكانت إجاباتهم كالتالي.
الشعراء خطيرون
وفي هذا السياق يقول الشاعر المصري أحمد عبد المعطى حجازى: لم تكن هناك نهضة بدون الشعر، ولا يمكن أن تقوم النهضة بدون اللغة، والنظر فى المستقبل، وهذا لن يحدث بدون الشعراء، مشيرا إلى أن السؤال عن مستقبل الشعر، مطروح باستمرار، وهذا أمر يطمئن الشعراء. وفي مطلع عصر التكنولوجيا وسيادة العلم منذ القرن الثامن عشر تنبأ الكثيرون بموت الشعر ليحل العلم محله؛ ولكن ما شهدته أوروبا خلال القرن التالى من ازدهار شعرى غير مسبوق على أيدى الرومانسيين فى فرنسا وانجلترا وألمانيا، ثم على أيدى الرمزيين مثل رامبو، كذب النبوءة بموت الشعر وجعل الإنسان المعاصر أكثر ارتباطا بالشعر، إذ أن الشعر يعد تجسيدا لقيمة الحرية فى أسمى معانيها، ولكن برأيى أن الشعراء ظلموا، وأن كثيرين لا يدركون إلى أى مدى لا يمكن للإبداع أن يتحقق إلا بالحرية. الشعر خطر، والشعراء خطيرون، ولا يصمت الشاعر أبدًا أمام الطغيان، والظلم والديكتاتورية، ولذا فإن إنقاذ الديمقراطية هو الحل، والحفاظ على الحرية هو الأهم.
بين الشعري والمقدس
ويتفق الشاعر العماني عوض اللويهي مع حجازي قائلا: “تقتضي الإجابة عن مستقبل الشعر النظر إلى تاريخ التجربة الشعرية، وعلاقة تلك التجربة بالبشر، وإن كان المجال هنا لا يسمح بالإطالة، ولكن بالإمكان أن نمعن النظر مليا في نشأة الشعر وعلاقته بالجانب الروحي والمقدس في الحضارات القديمة، فهناك ارتباط وثيق بين الشعري والمقدس بل إن الشعر يكاد يكون في بعض الحالات التجلي الأبرز للمقدس والمعبر عنه في ذات الوقت. فالحضارات حتى وإن انقرضت فالمقدس كممارسة يومية أو طقوسية ينقرض بالضرورة بسبب زوال ممارسيه ولكن نجد أن الشعر قد بقي ووصل وهجه إلينا.
الشعر يتأذى
ومن جهته قال الشاعر التونسي المنصف المزغني: يظل دائما هنالك مستقبل للشعر بأي معنى، لأن هنالك كلمات وأفكارا لم تولد بعد، وهناك جمل وعبارات سيقولها شعراء سيولدون في المستقبل، وهم في رحم المستقبل دائما. ولا يمكن لنا أن نرجم المستقبل ونقول أن الشعر الآن يحتضر أو يموت، ولكن لا بد من التأكيد على أن الشعر لم يعد يحتل المرتبة التي كان يحتلها في السابق. فقد تناهبت جمهوره قوى عديدة، ممثلة في فنون أخرى جديدة، إلى جانب ثورة الاتصال التكنولوجي. ولكن الشعر كفنٍّ يظل منوطا بعهدة من سيتعهدونه بالمراس، فربما يصير الشعراء أقلية، وربما نقلد الغرب في هذا البرد الذي يعاني منه الشعر، إذا علمنا أن الشعراء في الغرب لا يطبعون الدواوين بنفس الكميات والأعداد التي نطبعها نحن في العالم العربي، وإنما يطبعون في حدود 200 أو 300 نسخة من الديوان”.
أغنية الفقد
وتشاركنا الدكتور فاطمة العلياني برأيها في هذا الموضوع موضحة أن القصيدة هي أغنية الفقد في ظل تعدد أوجاعنا العربية، وهي البوح الذي يلازم الألم وبلسم لما يكتنز خلجات القلب .
وتضيف العياني: “الشعر هو ذلك البوح الذي تسرب إلى تكنولوجيا الاتصال فتشربت به، فإذا ما نظرنا إلى الجانب المشرق لذلك يمكننا القول أن التكنولوجيا ووسائل التواصل المختلفة عملت على دغدغة الذائقة الشعرية بما تحفل به من مقاطع شعرية صوتية وكتابية، فلم يعد الأمر محصورا بما يقتنيه القارىء من دواوين شعرية فحسب.
وعن مستقبل الشعر يظهر جليا بأن الشعر يظل الأداة التعبيرية الأقرب إلى النفس حين نغرق في بحار الفقد، وتلاطمنا أمواج الحروب والمجازر التي تفتك بالإنسانية”.
أجيال تكتب الشعر
الشاعر والناقد الفلسطيني الدكتور عز الدين المناصرة يعرب عن رأيه قائلا: إذا أردنا معرفة المستقبل وهو مجهول فعلينا أن نقيس على الماضي. فالقياس هو نوع من الاجتهاد في رسم الصورة، وأقرب زمن في الماضي هو الحاضر، أي أن ملامح الحاضر ربما لها علاقة بالمستقبل، أو تحاول أن ترسمه، لأن الظواهر لا تولد فجأة، وإنما تولد بالتدريج مع بعضها”.
ويرى الدكتور عز الدين المناصرة أن الشعر ضرورة حياة واحتياج حقيقي، وهناك أجيال من جديدة من لناس في المدارس والجامعات يكتبون الشعر، وأنا ضد توجيههم إلى نسق معين، بل نتركهم لابتكار ما تتفتح عنه قرائحهم، لأن هذا الذي سيمنحهم الفرصة لاستخراج شيء مغاير، وفي النهاية سيتصفون، مثلما بقي حوالي خمسة فقط من رواد الشعر الحر ومثله من الرواد في قصيدة النثر، وهكذا تتصفى وتتضح الأمور”.
كائن خرافي
أما الشاعرة السودانية روضة الحاج فتقول: “أرجو أن لا أكون متفائلة جدا ولكنني أرى أن واقع الشعر بخير ومستقبله أيضا بخير. لقد مر هذا الكائن الخرافي بمحارق عديدة ومتاريس كبيرة وبتحولات كونية ضخمة كان بإمكانها أن تجعل منه نسيا منسيا، ولكنه بعبقرية ما يحافظ على حقه في الحياة، بل ويضيف عبر هذه التحولات أشياء إلى نفسه فيصحو ويتألق ويدخل إلى فضاءات جديدة. وهذا بالحديث عن الشعر كظاهرة إنسانية عامة، أما بالنسبة للشعر العربي، فإنني عندما أتامل القصيدة العربية أرى أنها قد أفادت من هذه التحولا الكونية الهائلة ومن هذه التغيرات الرقمية والفضائية وارتقت بنفسها لتصعد إلى مكانة أعلى من الذي وصلته سابقا. لذلك فأنا مطمئنة على مستقبل الشعر وأعتقد أنه مثل الحياة يجد طريقه دائما”.