الثقافي
تلويح

عهود الزيدي
هل لوحت كفاك يوما..
لطائرة محلقة في فضاء لا ضفاف له؟ !
منذ أن بدت كنقطة لا متناهية،
ثم مرت من فوق رأسك، كحلم!
وتلاشت، ضائعة في المسافات والغيوم ..
هل تذكر أفكارك الطفولية؟
الطيار بإستطاعته رؤيتك
والركاب كذلك..
يتبادر لذهنك شيء مذهل..
رقصت في عينيك أمنية!
أن يشفق طيارها عليك!
يتوقف لبرهة ..
لتصعد ..
تحلّق بمعيّتهم..
تلامس أطرافك السماء..
وترى الغيم عن كثب..
في عمر طفولي لا يمكنه إستيعاب..
معنى وجود المطار!
من أجل ذلك..
بقيت مسافرا حائرا،
بين المسافات والغيوم.





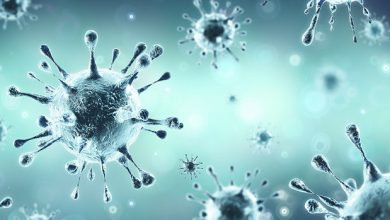


تلويح في صُبْح الطفولة، ما أجمله!