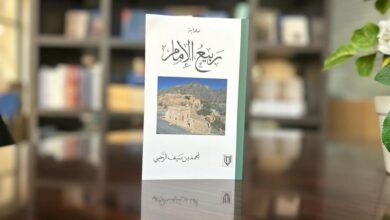مقالات
في ظل المتغيرات الوجودية .. النّفس تحتاج إلى جراحة عاجلة لتغيير مسارها

فوزي بن يونس بن حديد
لقد جعل الله عز وجل لكل إنسان أجلا محدّدا يقضيه في هذه الدنيا ويرحل منها مُكرها، لا يدري متى سيكون الرحيل ولا كيف سيكون وفي أي مكان سيكون، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ لحكمة أرادها المولى عز وجل، وقد نصل إليها وقد لا نصل، لكن الإنسان قد يعلم بطريق أو بآخر، أن الله تعالى عندما أخفى ذلك عليه إنما يريد أن يقهره في المقام الأول ليعرف قيمته البشرية وأنه لا يمكن أن يرقى إلا أن يكون إنسانا يعتريه النقص ولا يبلغ الكمال، وتعتريه الغفلة والنسيان، فهو ريشة في مهبّ الريح، جاء إلى الدنيا مُكرها ويرحل منها مُكرها وليس له في الدنيا إلا ما جنت يداه، ويأتي إلى الدنيا محتاجا ويرحل منها محتاجا ولا يأخذ معه شيئا.
كما يريد المولى عز وجل أن يجعل هذا الإنسان يعيش حياته بين الخوف والرجاء، بين الفرح والحزن، بين اليقظة والنوم، بين الصحة والمرض، وبين الفقر والغنى، تتبدل أحواله بين الفينة والأخرى ولا تستقر، ليعيش جميع الأجواء، ويعلم أن الخالق هو الذي خلق جميع هذه الأشياء وتسري عليه هذه الأحوال ولا تسري على خالقه، ومن ثم يسعى الإنسان ومنذ بلوغه سنّ الرشد إلى تنظيم حياته بنفسه دون تدخل من أحد حتى من الله تعالى فقال عز وجل: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾، فهو الذي خلق وسوّى وهدى، ومن أراد أن يكفر بعد قيام الحجة عليه فله ذلك، لكن هناك يوم سيأتي لا محالة للحساب والجزاء، فمقتضى العدل أن يحصل كل منكم على نصيبه وفق ما قدم من أعمال.
هذه الحقيقة الوجودية، هي الحقيقة الوحيدة في علم الله تعالى لا تتغيّر ولا تتبدّل ولا تتطوّر، وما على الإنسان إلا أن يسير عليها وفق وسائل تكفل له إنسانيّته وكرامته وعزّته، كما تكفل له حرّيته في الاختيار، هناك مقدّرات لا دخل للإنسان فيها لأنّه غير قادر على حملها وتحمّلها ولا يجازف بالتدخّل فيها لأن خسارته محتومة مسبقا، وبالتالي هو يعيش في الدنيا في كنف الله تعالى سواء اتّبع طريق الهدى أو طريق الضلال، منح الحياة للعالمين، وقسم الرزق بينهم، لكن الفرق بين المؤمن والكافر، أن الأول يعيش بين الخوف والرجاء، والثاني يستمتع بما أنعم الله عليه، يقول الحق تبارك وتعالى:
﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾.
كما أن الأول بعقيدته تلك يعصم نفسه من الموبقات والكبائر، ويقبل على جميع صنوف الطاعات وأعمال الخير والقُربات، ولا يعطي نفسه أكثر مما تستحقها ولا يطلب إلا الحلال الذي منه يتنفّس في هذه الحياة، فلا يجرؤ على استغلال غيره لأجل مصلحته ولا يمدّ يده لمال غيره، ولا يعتدي على بريء مهما كانت صفته وعرقُه ومذهبُه ولونُه، ولا يربأ بنفسه عن خدمة الناس والسهر على خدمتهم، كل ذلك وغيره يضعه في الحسبان أنه من أولى أولوياته، من رعاية نفسه وأسرته ومجتمعه وخدمتهم على حساب نفسه ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في ذلك وتحلى بالأخلاق الفاضلة حتى مدحه القرآن الكريم حينما قال:
﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وبيّن هو نفسه أنه جاء ليتمّم مكارم الأخلاق، حين قال عليه الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». بينما يسرح الثاني في هذه الدنيا كيفما شاء لا تحدّه حدود شرعية إذا لم يلتزم بها، ولذلك لجأ العالم إلى سنّ قوانين تضبط تصرفات الإنسان الذي ينزع إلى الهوى، وينساق إلى تلبية الشهوات، والفرق بينهما واضح للعيان.
ومن هذا المنطلق لا يؤخر المؤمن أعماله التي تحتاج إلى إنهاء، سواء المتعلقة بربه أو بالناس، حتى ينام قرير العين يحفظ حقوق الله وحقوق العباد، هو يأخذ من الدنيا ما يستحق، ويصرف جل وقته في طاعة الله تعالى، حيث تغمر نفسه القناعة والثقة بالله العظيم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه ما كان ليصيبه، بينما يظل الآخر يُمنّي نفسه بأنه سيعيش وسيفعل ما بدا له، وإن حدث ولامته نفسه فإنه سيؤجل التنفيذ إلى وقت آخر، ويلهيه الأمل بالحياة والبنيان والعمران والتشييد والربح والتنعم بالخيرات وغيرها من أسباب السقوط في فخ الشيطان دون رادع يردع أو يوجّه أو ينبّه، لكن الأمر يختلف عندما نجد من يتورّع عن ذلك خوفا من عقاب الله تعالى فيبدأ بغلق الملفات المفتوحة –إن صحّ التعبير-، وهي الملفات التي لم يحسم فيها المؤمن أمره بعد، سواء كانت متعلقة بشخصه أو بغيره.
من بين الملفات العالقة التي تحرج الإنسان في حياته وتتعلق بالآخر، الدّيْن بسكون الياء، وهو أمر ليس هينا، لذلك شدّد الإسلام على إبراء الذمة قبل الممات من خلال ما تبين من القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقوله :﴿من بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقوله: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ فكان الدِّين الحنيف حريصا على تخليص المؤمن من كل ما هو حقّ للآخر عليه حتى لو كان قليلا، ولذلك لم يصلّ الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل مات وعليه ديْن، فقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم»، ومنها أيضا تخصيص ورد قرآني يومي يعادل جزءا، أكثر أو أقل، لتكون صلة المؤمن بالله تعالى اليومية قائمة على كتابه عز وجل، وهذا طبعا لا يحتاج إلى تسويف بل إلى عزيمة وإصرار وتحدٍّ للنفس الأمّارة بالسوء، وإجبار النفس على النظام الجديد الذي تسطّره لها ومخالفتها لما تشتهي، والنفس لما تشتهي إقدامُ.
على أنّ الأمثلة كثيرة وواردة في حياة كل فرد منا، وكل شخص أدرى بملفاته التي تحتاج إلى جراحة موضعية قبل فوات الأوان وعليه أن يشرف بنفسه على هذه الجراحة خوفا من أن يأتي من بعده من لا يُحسن إجراءها، ويوقعه في تبعات قد لا يتخلص منها أبدا، وبالتالي على الإنسان أن لا يعيش على الأمل الذي يلهيه عن اتخاذ القرار الصارم في حق نفسه لإنقاذها من براثن العذاب في الدنيا والآخرة، وبراثن اللوم التي تكثر عند الإنسان لا سيما إذا علم أن الموقف أمام الله جادّ لا محالة، ولا عبرة بالتحدّث عن الأعذار لأن الوقت قد فات وأن الحساب قد حان، يقول الحق تبارك وتعالى:﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ويقول:
﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ ولا ننسى قسم الشيطان عندما قال لرب العالمين:
﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾ و﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وأيضا ﴿إلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾، وفي هذا الشأن أيضا ورد عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ» وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ».
فمن خلال هذه الأدلة تبين مدى خطورة الإنسان الذي يغرق في أمانيه ويعيش على التسويف فقد يختم حياته بحبه للدنيا وقد يكون ذلك سببا في شقائه لأنه لم يحسم أمره في كثير من الأشياء التي تتعلق بعباداته ومعاملاته، أغرته الدنيا والهوى والشيطان وبقي يعيش الأماني ولم يغير شيئا في حياته، أخذته الدنيا إلى حيث تشاء ومالت به الرياح حيث مالت، ولا يدري أن المنية تترصده في كل آن، لذلك كان الإسلام حريصا على أن لا يكون أتباعه ممن يستيقظون متأخرين، عليهم أن يحزموا حقائبهم مبكرين ويتأكدوا أن كل شيء على ما يرام قبل الإقلاع بأمان إلى بر الآخرة حيث الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى.