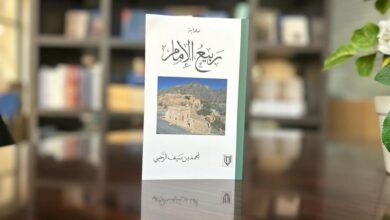مقالات
حرب “كوفيد 19”

محمد بن سيف الرحبي
مدن مغلقة وشوارع خاوية على أرصفتها، وقد كانت تضجّ بالحركة والحيوية عبر ملايين الأقدام التي تطرق أحجارها وإسفلتها ليل نهار.. ومطارات بحزن يتامى لا تحط فيها الطائرات ولا تقلع، وجوامع لا تضبط ساعتها على موعد صلاة الجمعة، ومساجد لا تستقبل الساجدين خمس مرات في اليوم، وأمكنة لا تحصى رفعت علامة “ممنوع الدخول”، حدائق، مطاعم، صالات سينما.. حتى اللعبة الشعبية الأولى في العالم، كرة القدم، أوقفت منافساتها، كأنما أصاب صفارات الحكام عطل مفاجئ، فأطلقت ما يشبه صفارات الإنذار على امتداد الكرة الأرضية، أن الزموا منازلكم، إن ابتغيتم السلامة.
ليست، تلك، مشاهد من فيلم سينمائي، ولا مقاطع من رواية تندرج ضمن أدب الخيال العلمي، بل حقيقة تمشي على الأرض، بطلها “خفي” لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكنه وحش كاسر قادر على فعل ما لم تستطعه الحروب، تلك التي خبرها البشر طويلا، وعملوا على تطوير أدواتها، وتجريبها على بعضهم البعض آلاف السنين، فإذا بهذا العدو ينسلّ على حين خفية، فيربك الدول، كبراها وصغراها، المحسوبة على العالم المتقدم، أو المتخلف، هم في المواجهة سواء، كأقسى ما تكون الصور تراجيدية، وكأنها مزحة ثقيلة امتدت أكثر من اللازم.
ليست مشاهد متخيلة، فرؤساء أقوى دول العالم، وهم حقيقيون وليسوا ممثلين يقومون بأدوارهم، يخاطبون شعوبهم لتوقّي هجمات هذا الوحش الخفي، كوفيد 19، بما أوتوا من حكمة وحذر وصبر، فلا يكفي أن يهبط الجنرال وزير الدفاع أو قائد الجيش ليقف أمام المنصة بنياشينه وأوسمته متحدثا يقنع الشعب بحالة طوارئ تبدو أشبه بموعد مضمون مع حرب كبرى، يلقي عليهم الأوامر، بل هبط القادة ليقفوا برهبة يخاطبون شعوبهم: عليكم أن تلقوا بجوازات سفركم بعيدا، وعليكم أن لا تصافحوا بعضكم بعضا، وأن تكفوا عن تفاصيلكم الإنسانية الاعتيادية، وأن لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى.. أن تهجروا رغباتكم بالمتعة في شرب قهوتكم المفضلة في مقهاكم الأثير، وأن، وأن، وأن..
وأن يتحدث رئيس وزراء بريطانيا لمواطنيه بوجوب “التباعد الاجتماعي” منذرا بأن عليهم توقع فقد “الأحباء” أمام طوفان قادم، لا يمكن صدّه أو مهاجمته بـ”الفيتو” ولا بحاملات الطائرات التي تجوب بحار الدنيا.
.. وهكذا خلت الشوارع من البشر، وصالات الانتظار في المطارات لم يعد بوسعها الإعلان عن موعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى بلد السفر، أو حتى العودة للوطن، وإلا فإن هناك حبسا منزليا يمتد 14 يوما، خشية أن يكون العدو قد تسلل إلى الجسد فيفنيه كالسوس يأكل منسأته، ومصيبا من حوله، فتتساقط أحجار الدومينو تباعا، على طاولة وأمام مرأى من لا يستطيع أن يحرك ساكنا لوقف هذا الهجوم العنيف، والسري.
لم يعش العالم مناخات هلع وخوف كالتي يعيشها على وقع تمدد رقعة “كوفيد 19″، في الحربين الكونيتين (1919 و1945) كانت الساحات معروفة، والعداوات بيّنة، بين تحالفات وأطماع، معسكرين يتواجهان، والثورة الصناعية ما زالت في بدايات عطاياها، لم تهب الإنسان ما وهبته إياه في عصرنا الحاضر، عصر الثورة الصناعية الرابعة، لكن مع هذا العدو الجديد تبدو البشرية كلها في خندق واحد، تسارع الوقت لتستفيد مما خبرته من علوم لوقف تمدد هذه المصيدة الضخمة وهي تبتلع المزيد كل حين..
إنما بقيت مختبراتها عاجزة، وعلماؤها حائرين، العدو يحتل المزيد من المساحات، ويوقع في شباكه آلاف الضحايا يوميا، بينهم من يموت، أو يوشك على الموت.
يأتي السؤال: من أين جاء هذا العدو؟!
من زرع أول ألغامه في أوهان الصينية، ثم سافر به إلى قارات الدنيا، كمتخفّ يوزع منشورات سرية، ويحتاج إلى أجهزة ضبط عالية الدقة لضبطه متلبسا؟!
هل هي حرب بيولوجية لمعاقبة الصين على تطلعاتها كقطب جديد سيأخذ الدور الأمريكي، وله من القوة، والصبر، والحكمة، والانتشار، ما يؤهله لوضع “الراية الحمراء”، بالنجمة الكبيرة التي تراقص أربع نجمات أمامها، مكان العلم ذوي النجمات البيضاء الخمسين؟!
كان العالم يفتش عن رائحة حرب حقيقية، غير تلك المتخفية وراء ما يسمى “بالكورونا” وفيروسها المستجد، حرب يفهمها ويحللها ويتخندق في طرف ضد طرف، تضاف إلى حروب قائمة تبدو كأنها خرجت من المشهد أمام ما يحدث، فنشرات الأخبار، وسائر وسائل الإعلام، قديمها وحديثها، لا حديث لها سوى عن هذا العدو الخفي، فتراجعت صور الدبابات وقاذفات الصواريخ أمام كرات خضرات تبدو أشبه بألعاب الأطفال، أو مخترعات لطيفة لفيلم تشويقي عن حرب النجوم.
يحتاج المشاهد لعناصر إثارة، فلا يكتفي ببقائه محاصرا ضمن جدران بيته، دون أن يفهم جيدا ما هي تفاصيل اللعبة التي ينثرها “كوفيد 19” على رؤوس العالم، فتتصدع قمم، وتئن اقتصادات، وتحفر هاويات، وتوضع الأيادي على القلوب مخافة الأسوأ، مع أنه يشهد كل يوم ما هو أسوأ من الأمس، لكن النفس البشرية واجفة أمام المجهول ومرتعبة بما يكفيها لتمنع الحياة أن تمشي باعتيادية على شوارعها، فمربك خطو هذا الكوفيد اللعين، يضرب من حيث لا يدري أحد، يتخفى في جسم مسافر، يمشي رغم أنف موظف الأمن المدجج بسلاح الكلاشينكوف والأجهزة الإلكترونية القادرة على رؤية الشرايين داخل الجسد الآدمي، إنما “واثق الخطوة” يسير بخبث، ضاربا بذبذباته العشرات دون أن يدركوا ما الذي يحدث، أو أن هناك ما يحدث فعلا، فيحمل المصاب ما يجعله قابلا لإصابة غيره، وربما بالجملة.. وأهرامات الرمل تتهاوى!.
من أوهان الصينية سار الفيروس، هكذا يقال، وهكذا يجب تصديق ما يمكن أن يقال، تخلصت الصين من بؤرة ميلاده، وصلت بؤر عدة، بكيفية ما، إلى القارة العجوز، الدول المتقدمة، بدأت باجتياح إيطاليا، عشرات الآلاف من المصابين ومئات الوفيات، وصلت الجائحة إلى إسبانيا، الكل يغلق حدوده، والرئيس الأمريكي ترامب لا يستثني أحدا فلا طائرات تأتي إلى القارة الجديدة، ولا يعرف القطب الوحيد إلا ما يحمي بلاده وسلامة مواطنيه.. فلا صداقة إلا المصلحة.
كم من الوقت يحتاج هذا العالم، بكل ما أوتي من جبروت التقنية، ليحاصر هذا الشبح المرعب، وكم يبدو له قادرا ليحصي خسائره وتبدو هائلة جدا، رغم توحد البشرية، وفي حالات نادرة، لإيجاد مصل يقيها مثل هذه الشرور الطارئة.
مئات المليارات تبخرت في هواء “كوفيد” التاسع عشر، هذا الغاضب مما تفعله البشرية من قتل وتدمير في بعضها البعض، وبأقصى ما تستطيعه التقنية ومخترعات العلم من قدرات إهلاكية جبّارة، خرج من اللامرئي، متخفيا، متحديا: ابحثوا لي عن قاتل إن استطعتم، لكنني وحتى ذلك الوقت سأستمر في مهاجمتكم وقتالكم، معشر البشر!، عالمكم الذي أدمن “التواصل الاجتماعي” عبر وسائل ووسائط جاء فيه من يدعو إلى “التباعد الاجتماعي”، كأن في ذلك درب السلامة.
سنحتاج إلى زمن لفك حالة الغموض حول هذا الفيروس، مسبباتها وتداعياته، والدروس المستفادة، لأنه لم يكن مجرد فيروس، بل صفعة قوية في وجه العالم ليستفيق البشر على واقع جديد، حيث يمكن أن يحدث ما حدث، في عالمهم المضيء بالمخترعات والمكتشفات اليومية، فإذا به أمام لحظة تاريخية ترتبك الحياة، كما لم ترتبك من قبل!.