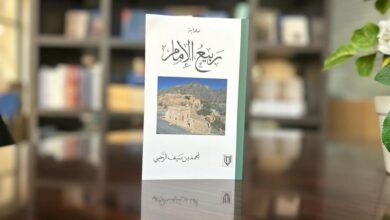مقالات
رسائل إلى صديقي السري

مروة يعقوب
(٢٦)
صديقي المذهل..
العزيز ، والخاص جدا..
أراك بأحسن حال، كيف تراني؟
سأخبرك عن تلك الأنفس التي تعود انتقاما لا صلحا.
أسمعت عن الرماد الذي يُطفئ النار؟
قوة من ضعف. قوة تحالُ إلى الموت.
يرغب المهزوم بنصرة نفسه فيشعلها -دون أن يدرك- ليحرق ما حوله، ولا يفكر بمن يحترق أولا. سيكون أولهم.
يتنازل عن أشياء لم يكن تركُها ممكنا قبلا.
يسيء الإنسان لنفسه جهلا منه حين يفكر بالعودة انتقاما، تسقط فضيلة العائدين حين يكون باطنها بشعا هكذا.
صديقي السري..
التصالح مع الذات كذبة!
التصالح يعني الصفح التام، ونسيانًا لا يُحيله الزمن تذكرًا.
الإنسان أناني بشكل ما، أبسط أشكال أنانيته في رغبته أن يبقى مُتَذَكرًا، لا يتجاوزه الآخرون وإن كان قد استقر بعيدا عنهم. يريد أن يكون كثير الحضور في أفكار الآخرين.. يفكرون به.. لا يحبون غيره، بينما يعيش هو في راحة أخرى واستقرار!
لست مثالية، لم أتصالح مع نفسي، أريد أن أبقى في ذاكرة البعض، لكن لا أريدني هوسا يشل راحتهم.
وأيضا.. نحب الأشياء الناقصة لنكتمل بها، وما كل ناقصٍ يكملنا، فكيف ننسى؟
صديقي العزيز..
إني أشد حذرا من أن أحرق نفسي.
وجدتُ لي مخرجا من تلك الحالات، فحين أريد إسناد أحدهم إلى اللاشعور أجعل اسمه في قائمة الأسماء بهاتفي طويلا.
سيُدهشك إن أخبرتك أن الأمر ينجح معي، ينجحُ كثيرا إلا في حالة واحدة، كانت الأصعب، أحلتُ فيها الاسم إلى أشكال عدة قبل أن يفقد تأثيره بي، لكنني نجحت وأخيرا.
كُن بخـير لأكون كذلك،
صديقتك السرية المذهلة مثلك.
(٢٧)
صديقي العزيز..
الربكة التي تأتيك بها الدهشة، أتعرفـها؟
ستعجب لو أخبرتك أنك قد تصبح غبيـا في حضرة أحدهم، ستسقط مِـنك كلمات لا تعيها، ولا تدرك لأي مدى ستكشف ستر قلبك. الربكة تلك يا صديقي.. عليك أن تتعلم كيف تكبحها، واعلم أنها ليست إلا إحدى مقدمات الإعجاب المتبوع بالحُب (غالبا)، أِثبت إن راودتك مُغافلةً حرصك، فلن تحتمل احمرار وجهك خجـلا في لحظات ساخنة كتلك. إن تواطـأ الوقت معك في حال كهذا فلا تسلّمـه عقلك، تمسك بذاتك حتى ينكشف الغموض الذي يـتوشحه الآخر!
أنت حقا لا تريد أن تمرر كفيك على وجهك مرات متتالية حتى يكاد ينسلخ عن رأسك! لذلك أُحرص عليك، توخ حذرك.
أحذرك.. لا خشية عليك من الحُـب، أحذرك لأن الحُـب إن سكن قلبك فلن يكون انتزاعه سهلا، الأمر بسيط ومعقد، ولن يكون محل حديثنا في هذه الرسالة؛ هناك أشياء أهم أرغب مشاركتك إياها.
ملاحظة: إذا قبل الحُـب إحساسك فاقبض على قلبك، ثم أبلغنـي؛ قد أعلمك كيف تعيشه كنعيم أبدي.
صديقي الخاص جدا..
هذا هروبي الأول، أتعرف معنى أن تكون شديد الحذر ثم تقع في فخ حذرك الشديد؟
كنت في موعد للرقص مع «زوربـا اليوناني» إلا أن عقل صديقتك لم يتوقف عن مشاكسة أحاسيسها، أغلقت الرواية، ودققت النظر للجدار المقابل، هناك رأيت رسما لكل الأفكار التي يتلعثـم عقلي كلما حاول مصارحتي بها. أعيذك يا صديقي (حبا) من هكذا حال، وإن كنت راغبـا بعبثية المشاعر هذه، فلا خيار نملكه إلا أن يسنـد أحدنا الآخر.
لا يعلم أي منّـا متى تشاء الخيبة التسكع في داخله، تنهـش أجزاء جسمه، تبتر مشاعره، وتبصق بحنـقها على رئتيه متسببـة بضيق في التنفـس.
تأتيك بعد جرح مهذب، يسكن دمك، يتحرك دون توقف، ينعش ألمك كلما تناسيته، جرح لذيذ، تشتهي مد ذراعيك إليه ليضمك؛ لأنك تعتقد أنك لن تنضج لولاه، وحدها الجراح اللبقة تعرف كيف تلسع شقاوتك، فتجعلك «بالغا وعاقلا» مع بعض الجنون الخفي.
ملاحظة حولك:
تعرف كيف تُبقيني على استمرار معك، لا تكتب لي بخط يدك؛ لأنك تعرف أنني أحرص على امتلاك خط يد الأشخاص المميزين بحياتي قبل أن أصنع مسافة تفصل أعينهم عني. لا تقلق.. أخبرتك مرات عدة، إن فكرت أن نلتـقي فلن تحتاج إلا لعقلك وصوتك، لن تحتاج لعينيك أبدا، أعدك.