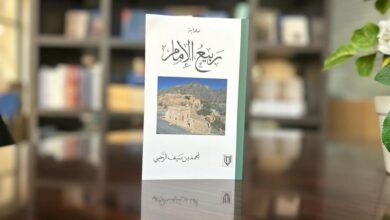مقالات
بناء الوطن.. بين جيلين

وأنا أقرأ كتاب «هُنً» للزميلة الصحفيّة عزيزة بنت سليم الحبسية الصادر عن دار الغشام، تذكرتُ ما قاله لي مرةً الأستاذ مراد بن علي الملاهي، بأنه نال شهادة الماجيستير من باكستان عام 1968، واشتغل فترةً بسيطة في أبوظبي، قبل أن يعود إلى الوطن، بعد أن سمع – مثل الكثيرين – نداء صاحب الجلالة السلطان المعظم للعمانيين أن يعودوا إلى عُمان ويشاركوا في بناء الوطن. فكان ممّا ذكره لي، أنه اشتغل في البداية في مجلس التخطيط، إلا أنه انتقل للعمل في التربية والتعليم، فكان هو وكلُّ من معه يشتغلون في كلّ شيء؛ فهم المديرون وهم العُمّال، بل اشتغلوا حتى حمّالين؛ فعندما كانت تأتي الكتب المدرسية من الدوحة، كان الكلُّ يتسابق للعمل، حتى تصل المناهج إلى الطلاب في المدارس مع أول يوم دراسي. وقال «كان هدفنا أن نواكب التقدم، وكنا مدفوعين بحب خدمة الوطن، ولم تكن المسميات الوظيفية هي همّنا».
زاهر بن حارث المحروقي
كان ذلك الجيل، جيلاً ذهبيًا مميزًا، إذ قامت النهضة على أكتافهم، وهم الذين بنوا عُمان مواصلين الليل بالنهار، معطين جهدهم ووقتهم لبناء البلد، بكلِّ أمانة وإخلاص؛ إذ كان بناءُ الوطن والإخلاصُ لجلالة السلطان هو شعارهم، وأنكروا ذواتهم في سبيل ذلك، فكانوا الأساس واللبنات الأولى التي قامت عليها الدولة دون مقابل يُذكر. وقد ذكرتُ سابقًا أنّ منهم من ذهب إلى النسيان ولم يحصل على شيء، ومنهم من عانى بصمت، ومنهم من حمل في قلبه الأسى لما وصل إليه حاله.
والأستاذ مراد، لم يكن الوحيد الذي ترك عمله في الخارج وعاد إلى الوطن؛ فالقائمةُ طويلةٌ جدًا لأشخاص تركوا مناصبهم وامتيازاتهم في الخارج وعادوا إلى عُمان، تلبيةً لنداء الواجب، رغم الظروف الصعبة في تلك الفترة.
وأنا أقرأ كتاب «هُنّ»، وجدتُ أنّ هناك من النساء من تشابهت ظروفُها مع بعض الرجال الذين درسوا وعملوا في الخارج، إلا أنهم ضحّوا بامتيازاتهم وعادوا إلى الوطن، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بهم وبأعمالهم في تلك الفترة الصعبة. وتأتي آسيا الخروصي في مقدمة هؤلاء؛ ففي مقابلة أجرتْها عزيزة معها ونشرتْها في جريدة عُمان، عدد 12 يونيو 1994، تحت عنوان «آسيا الخروصي.. ذاكرة بين وعورة الزمن والتضاريس»، – وهو عنوان ملفت ومعبِّر – تعرِّف عزيزة ضيفتَها التي كانت تعمل حينذاك مديرة دائرة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة، بأنها دخلت كلية التمريض في بريطانيا عام 1960، وأكملت الدراسة عام 1963، فاشتغلت في بريطانيا لمدة ثمانية شهور، وبعدها التحقت بمعهد التوليد عام 1965، واشتغلت في السعودية لمدة ثماني سنوات، ثم رجعَتْ إلى عُمان عام 1973، وقد تم تعيينها في مستشفى سمائل كمسؤولةٍ عن التمريض بالمستشفى الذي كان جديدًا وقتها. ولكي نعرف قيمة هذه المقدمة عن واحدة درست واشتغلت في بريطانيا ثم في السعودية ثماني سنين، لا بد أن نركز على ظروف مستشفى سمائل الذي اشتغلت فيه في تلك الفترة.
تقول آسيا الخروصي: «في تلك الفترة لم نكن نملك لا أجهزة اتصال ولا كهرباء؛ فقد كان المستشفى يعتمد في توليد الطاقة على ماكينة خاصة، ولم تكن توجد شوارع، وحتى سيارة الإسعاف لم تكن عندنا، وعندما كنّا نريد أن ننقل المريض من مستشفى سمائل إلى مستشفى النهضة ومستشفى خولة في العاصمة مسقط، كنّا نستخدم سيارة (البيك أب)، وكنّا نضع البطانيّات كغطاء واق للمريض، حتى لا يصل إليه الغبار والأتربة، وكنّا نضع السقّايات في الإطار الحديدي للسيارة، ونقوم بإيصال المريض إلى العاصمة في أيِّ وقت، سواء كان في الليل أو النهار، وكنّا نقوم بهذا العمل مرتين أو ثلاث مرات يوميّا، في مسافة كانت تُقدّر بساعتين من سمائل إلى مسقط في ذلك الحين، على طرق الأودية والجبال والأتربة»، وتصف آسيا الخروصي مستشفى سمائل، بأنه افتتح بثلاثة أطباء وسبع ممرضات، وكان المستشفى يعمل طوال 24 ساعة، وقد بنيت الخدمة هناك ليس على أساس موظف ومواطن، بل على أساس الاحترام المتبادل والإخلاص؛ ففي أيِّ وقت كان المريض يأتي للمستشفى وإن كان الطبيب غير موجود يتم استدعاء الطبيب من بيته. وتشير «كنّا نعمل بروح الفريق الواحد، فكنّا مثل فريق كرة القدم الذي أمامه هدف واحد، وأننا لم نكن نملك ملابس للمرضى المرقدين؛ فكنا نقوم بدور الخياطات والممرضات في آن واحد، وقمنا بإعداد ملابس للمرضى».
وتقول آسيا الخروصي: «لا يستطيع الجيل الجديد أن يتصوّر كيف كان الوضع فيما مضى؟ للأسف لم تكن هناك كاميرا فيديو حتى نصوِّر ما كنّا نعانيه، وننقله لأولادنا حتى يتعلموا ويعرفوا كيف كانت عُمان بالأمس، وكيف أصبحت اليوم؟، وحتى يعرفوا أننا لم نصل إلى ما نحن فيه ونحن قاعدون، بل عملنا واجتهدنا وصبرنا حتى بلغنا هذه المرتبة؛ ومع ذلك كنّا سعداء، لأننا كنّا نجد النتيجة المباشرة لعملنا».
ما قالته آسيا الخروصي في الفقرة الأخيرة، يُعتبر درسًا يجب أن يأخذ طريقه إلى الأجيال الجديدة؛ فعُمان الحديثة لم تُبن من فراغ؛ فقد كانت وراء ذلك جهودٌ كبيرةٌ لأناسٍ أنكروا ذواتهم، وكانت «الوطنية» هي كلمة السر لديهم؛ فلم يُقدّموا الحقوق على الواجبات، ولم يكن همّهم الأخذ دون عطاء، ولكن تكن كلمة «الأنانية» معروفة في قاموسهم، وما كان يُنجزه شخصٌ واحد في تلك الفترة، لا ينجزه العشرات من الموظفين الآن. ولا يمكن أن نقول إنّ هناك خللا في الجيل الجديد، وإنّما الخلل يكمن في الطريقة التي تم تأهيل الشباب بها، وفي الطريقة التي تمّت بها عملية التعيين. وربما نحتاج إلى تثقيف الجيل الجديد بثقافة «الحقوق والواجبات»، وأن يكون ذلك قبل التعيين، وأن تكون هناك مادةٌ صريحة يوقّع عليها الموظف تُظهر له ما هو المطلوب منه وما هو حقه؛ فالمؤشراتُ تدل على أنّ المستقبل تحيط به بعض الصعاب، إذا لم تبادر الدولة إلى إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، وإلى مراجعة أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، بأن يتم التركيز على مبدأ «الحقوق والواجبات»، حيث توفر الدولة الظروف المناسبة للعمل، ثم يحقّ لها بالتالي أن تحاسب من أخل بواجباته، وهو مبدأ عادلٌ تمامًا. وأجدني أميل إلى إعادة نشر ما كتبته في مجلة «القلق» الإلكترونية تحت عنوان «ما بين الحقوق والواجبات»، وهو أنه ما يؤسف له أنّ «المواطنة الحقة» بدأت تختفي من الجيل الجديد، وصار الإنسان لا يفكر في الواجبات التي عليه، وأصبح تفكيره منصبًا في الحقوق فقط، وأصبح الأغلبية تتجاهل وتتناسى ما عليها من واجبات، ولا يهتم الشباب إلا بأنفسهم؛ فيرون الحق من زاوية ضيقة فقط، هي زاوية المصلحة الشخصية، ويتحدّثون دائمًا عن حقوقهم دون النظر إلى واجباتهم.
وغيابُ «المواطنة الحقة»، جاء نتيجة لأسباب كثيرة، يأتي التعليم في مقدمة هذه الأسباب، بغياب المنهج الجيّد الذي يبني الأجيال؛ وبغياب الخبرات الكبيرة في مجال التعليم؛ كما أنّ هناك أسبابًا أخرى، هي غياب هيئات تتبنى الشباب وتُشغل وقت فراغهم بالمفيد؛ فغاب عن الجيل مفهوم الإخلاص والولاء للوطن، وغابت عنه قيمة الوطن، لأنّ الشباب نشأوا على مفهوم أنّ الوطنية هي مجرد احتفال وأناشيد، تُبثّ عبر وسائل الإعلام. وما أراه – وأتمنى أن يأخذ طريقه إلى التطبيق يومًا ما – أننا نحتاج إلى حصتين من الصف الأول الابتدائي وحتى السنة الأخيرة من الجامعة، تحت اسم «التربية الوطنية» و»الأخلاق»، لأنّ ما يواجهنا الآن من التحديات في الجانب الوطني والأخلاقي هو كبير وقد يكون خطيرًا.