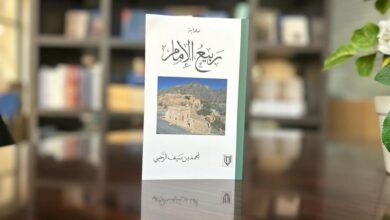مقالات
السياحة “تثري”؟!

زرت صلالة مرتين في موسم «الخريف» الذي عدّ استثنائيا هذا العام، ومع ذلك فإن نسبة ارتفاع عدد الزوار عن العام الماضي 28 بالمائة، وهي نسبة يفترض تحققها تلقائيا مع كل موسم، إذا كنا نعمل على التطوير الحقيقي المستفيد من عنواننا الضخم «السياحة تثري»، فيما بلغ عدد الزوار 800 ألف زائر، أغلبهم من السلطنة، أي أن السياحة الداخلية الرافد الأساسي للموسم، بينما كان التعويل على السياح من الخارج لما يشكله ذلك من مردود اقتصادي أفضل يساهم في إجمالي الناتج الوطني للبلاد.
في الزيارة الأولى حضرت فعالية توزيع جوائز الإعلام العربي، ولا أريد الخوض في طبيعة الجوائز واستحقاقها، حيث إن الفائدة الأكبر رأيتها في حضور صحفيين عرب أدهشتهم صلالة، وبقية الأمكنة في محافظة ظفار، مع أهمية الإشارة دوما إلى اختزال الموسم السياحي في مفردة (صلالة) بينما كل ولايات المحافظة تشكل إضافة طبيعية رائعة إلى عرس الطبيعة في صيف شبه الجزيرة العربية الحارق.
كانت (الطبيعة) على أروع ما تكون.. كما هي هبة الخالق لهذا المكان الجميل.. لون أخضر وعيون مياه تجري متدفقة ومطر ناعم استمر نحو مائة يوم (على سبيل التقريب لا التحديد الدقيق)..
لكن ما هو دور (البشر) في الاستفادة من ذلك الجمال الأخّاذ لتحويله إلى إضافة حقيقية للسياحة المحلية، ويتحقق مفهوم (الثراء) في الحسابات الاقتصادية الوطنية؟!
شخصيا لم أشعر أن هناك دورًا يوازي ما عرفته المحافظة من طقس استثنائي أدهش الزوار كأنما لم يعرفوا موسما يشبهه على مر سنوات طويلة.
هل المطلوب فقط إقامة المهرجان في المركز الترفيهي أو تحويل الأمكنة السياحية جميعها إلى مراكز ترفيهية؟!
هل دور البلدية يعتمد على توفير حاويات القمامة ونشرها في مختلف الأمكنة أو توفير سائر الخدمات التي يحتاجها السائح ومن أهمها دورات المياه التي تحترم آدميته كونه سائحًا يرغب في أن يرى الرقي في كل جوانب المكان، بما يعكس هوية هذا المكان، وهي المعروفة والمتداولة، وأهمها: النظافة.
هل وضعنا شعار «السياحة تثري» حين نخطط لأي موسم سياحي، خاصة خلال الفترة الذهبية التي تعرف فيها محافظة ظفار، وأشدد على المحافظة كاملة وليس على ولاية واحدة، لوحات جمال طبيعية نادرة في محيط تتجاوز فيه درجة الحرارة الخمسين درجة مئوية؟!.
وماذا بعد؟!
لا أضيف جديدا من الأسئلة، لأنها تثار من قبل الكثيرين، ولأنها تثار كل عام، ويسمعها المخططون في بلادنا، ولكن لأن هناك حالة شلل في التفكير الإبداعي فلن نسمع إلا تلك التصريحات الجوفاء بأن المحافظة مستعدة, والجهات مستعدة، كما هو الحال في مهرجانات أخرى تتناسخ من بعضها البعض.
زرت المركز الترفيهي في آخر يومين من المهرجان، وجدته كمن يقاوم الشيخوخة والزمن لكي يثبت أنه ما زال حيًّا يتنفس، المكان فاقد للحيوية، الباعة الآسيويون يعملون بدأب في ساحة البيت التراثي خلال الحفلات الغنائية اليومية، آخر ما تبقى من حيوية رغم ما يمكن أن يقال عن تلك الأمسيات، لكنها تبقى الملاذ الأخير لزائري المهرجان فلا شيء آخر سوى المحلات الصغيرة للألعاب والمطاعم، وهذه تثري الوافدين أكثر، فلم ألحظ أي مواطن يعمل في جميع الأمكنة، وصولا إلى المعرض الاستهلاكي، المستقطب لمختلف الجنسيات.. إلا الجنسية العمانية!.
وحين نستعيد سيرة «الموسم» مع استراتيجياتنا السياحية نتذكر تصريحات حول مشاريع لم تر النور، أعلن عنها على لسان كبار المسؤولين، ومن بينها عربات «التلفريك»، متعة أخرى يعيشها السائح، بجوار أفكار ترفيهية أخرى توازي ذلك الشغف (أو الاستسهال) لتقديم الفنون الشعبية مع الحجّة الحاضرة والجاهزة بأنها تراثنا وهويتنا وغيرها من المفردات التي تواجه كل من يرغب في التجديد والتخفف من زحمة هذه الفنون، في كل مهرجان وفعالية، كأنما نعيش زمنا غير زماننا، واحد نراه في المهرجانات، وآخر كما نعرفه في أسلوب حياتنا ومعيشتنا.
ما هو الحل؟
ذلك السؤال يطرح إن كان ثمة إحساس بمشكلة ما، أما على ألسنة القائمين على الأمر فإن الأمور على خير ما يرام، والجهود كبيرة، وليس هناك من خلل إلا في الأقلام غير المنصفة التي لا ترى حجم الجهود والإنجازات العظيمة.
لا يمكن التقليل مما أنجز خلال السنوات الماضية، وهذا واضح للعيان، ولكن يبقى معيار مهم، أنه بالإمكان أفضل مما كان، وطبيعة الحياة أن هناك لسقفنا للأمنيات علينا أن نبلغه، لكن من المسؤول عن بلوغ ذلك، والتفكير بشكل إبداعي سقفه أرفع مما يراه القائمون على الحدث، مع أني لا أميل أبدا إلى تحميل بلدية ظفار كل المسؤولية عن تحقيق أقصى استفادة من الموسم السياحي في المحافظة، لكن هل هي تلك الشراكات الغائبة أو الجهة القادرة على لمّ شتات الجهود لتقدم فعلا سياحيا حقيقيا يضيف للمكان قيمة معنوية ومادية، ويرفع من جودة المنتج السياحي ليتوازى مع بهاء الطبيعة، ويستمر العطاء مع فترة ما بعد الموسم حيث الجمال يبدو متجليا تحت أشعة الشمس.
كل ذلك يقال قبل كل موسم، ويقال خلاله وبعده، ويأتي العام التالي بلا جديد، ونبقى نحن عشاق المكان في صدمتنا، أن هناك مناطق تعرف كيف تستفيد من عوامل الطبيعة، بينما يتجلى كل ذلك الجمال على أراضينا ولا نعرف إلا أن ننظم مهرجانا ونأتي إليه بذات المفردات المتكررة عاما بعد عام!!
لدى الناس قابلية أن يدفعوا إن وجدوا المكان المهيأ بالخدمات، كما نفعل حينما نسافر، وندفع حتى بدون خدمات، لأمكنة طبيعية الدخول إليها برسوم، قد تبدو بسيطة أحيانا وغير مؤثرة للزوار، لكنها داعمة للدخل، ولتكن في موسم الخريف أو في غيره، مخصصة لصندوق يحمل اسم «تطوير السياحة في المحافظة»، لتصرف على تنفيذ أفكار تحقق قيمة إضافية أخرى..
افسحوا للشباب
في سائر أروقة العمل السياحي، كما في غيره، أكاد أجزم بأن شبابنا يمتلكون أفكارا قادرة على التطوير، من خلال عصف ذهني تقدم فيه الأفكار بجرأة، دون أن تصادر من خلال أولئك القابضين على مقومات العملية التنفيذية منذ عشرات السنين..
أعطوهم الفرصة ليعيشوا حياة عصرية هم أدرى بمفرداتها أكثر من جيل سبقه ما زال يعيش تحت سقف الأمس، ويبتهج بالقرية التراثية أيما ابتهاج..
تلك صناعة الأمس، لكننا نحتاج إلى صناعة اليوم، كما يفهمها أبناء اليوم، قد يطورونها، ويضيفون إليها، لكن لا تحرموهم من فرصتهم.
سريعا:
حينما تبقى إنارة شارع غائبة لعدة ساعات، ويستمر الأمر أياما فإن المسألة أعمق من (عطل) طارئ.. فهناك (العطل الأصعب) في الفكر الذي يتولى المتابعة، والاهتمام… وربما في الفكر المتابع، القائم بدور: المحاسبة.
حينما تنبري شركات الاتصالات بالدعاية لنفسها كما يحلو لها، فإن ذلك يصبح من حقها إن كان كل شيء على ما يرام، وأن شارع مسقط السريع (مثلا) لا ينقطع فيه الاتصال لضعف الشبكة، أو «تعذر الحصول على المشترك المطلوب» الذي عليه أن يبلع غيظه، ويدفع فاتورته قبل «قطع الخدمة».
يقوم البعض بالتقليل من كل شيء.. اعتمادا على قدرتهم في فعل (كل شيء).. وبامتياز، مدققين كثيرا في أخطاء الآخرين، حتى إذا سنحت لهم الفرصة في الجلوس على تلك المقاعد التي كان يجلس عليها أولئك الذين يسمون بـ(الآخرين).. ستنقلب المعادلة.. في كل شيء.
لا يحبون الرقيب، منحازين للحرية دوما.. ومع ذلك ما يفعلونه أسوأ، ويقطع فعل الحرية حتى عن.. فهمهم، باختصار: لأنهم يرون الحقيقة في أيديهم وحدهم، وما في يد الآخر لمعان وهم.. ليس إلا.